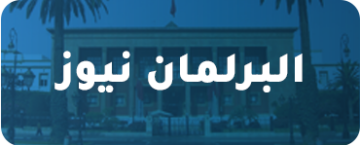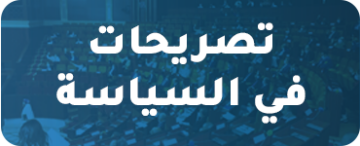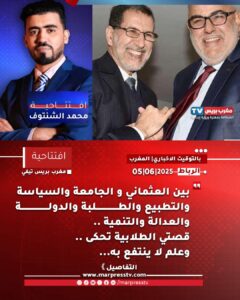بين العثماني والجامعة والسياسة والتطبيع والطلبة والدولـة والعدالة والتنمية .. قصتي الطلابية تحكى .. وعلم لا ينتفع به…
بين تجربتي في الجامعة واهتمامي بفن التواصل وبعلم السياسة وعلوم أخرى.. العثماني رجل دولة ومثقف وجب توقيره والجامعة فضاء للعلم والاختلاف بالعلم لا “بالبلطجة” .. أما العدالة والتنمية فلكم الكلمة، لنبدأ الكتابة، ولتركزوا في القراءة دون خلفيات، دون أحكام مسبقة، ودون رغبة في بناء المواقف للتمهيد للصراع والحقد، وإنما للفهم والتحليل، وليمضِ كل في حال سبيله في الوجهات المختلفة، بقبعاتنا وأفكارنا المختلفة، متعايشين تحت سقف وطن واحد يجمعنا جميعا.
فهابرماس يؤكد أننا إذا أردنا أن نتواصل فيجب أن نتواصل في إطار ما أسميه حسب فهمي لنظرياته “بالعدالة التواصلية”. هذه العدالة تفرض علينا أن ندخل لعمليات التواصل كالورقة البيضاء، وفي نفس مستوى النضج التواصلي، أنا لست أفضل منك وأنت لست أفضل مني؛ نتواصل لنتبادل في سياق وحول مواضيع دقيقة، والإخلال بالعدالة التواصلية من أي طرف يعني الدخول في أزمات التواصل، وهو بالضبط ما نلاحظه في المغرب على عدة مستويات.
🔹الحركة الطلابية بالمغرب وغياب النقد الذاتي
في ظل ما تعيشه الحركة الطلابية من تراجعات واضحة للعيان، أو هو تكريس لثقافة سائدة ترفض النقد الذاتي للسلوك والفكر، وتركيز بعض “الحركات الطلابية” على غرار “بعض الفاعلين السياسيين” على تقديم خطاب يتناقض مع السلوك، وسلوك لا يغني ولا يسمن من جوع، يتكرر في كل موسم جامعي، دون أن يساهم في تعزيز ثقافة الحوار ولا في تقديم البدائل، كأننا يجب أن نتكلم فقط لنتكلم أو نكتب فقط لنكتب أو نعبر عن موقف ورأي فقط للتعبير، في حين أن ما لا أثر له يجب أن يُعاد تقييمه ويُستبدل بخطاب وسلوك جديدين. السوداوية المبالغ فيها لا معنى لها، لا زلنا ولسنوات عجاف طويلة أمام آلة فكرية ديماغوجية تنتج خطابًا “طائفيا أو عنصريا متجاوزا” يقوم على إقصاء الآخر ورفض الاختلاف. فقد يصبح هذا المقال مثلا مبررا للهجوم على كاتبه واتهامه بما ليس فيه. هي أساليب متخلفة لا زالت قائمة في مغرب 2025، لكنها لا ولن تؤثر وستظل ننتقدها حتى يعي أصحابها ضرورة إجراء نقد ذاتي وطرح سؤال: ما الجدوى؟
🔹الإتحاد الوطني لطلبة المغرب وفق فلسفة خاصة
نظير ما ذكرناه وما لم نذكره، أصبح لزاما علينا أن نكتب عن “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب” وفق الفلسفة التي آمنا بها عندما كنا طلبة في الرباط بصفة خاصة، وهي فلسفة تقبل الاختلاف بجميع أشكاله داخل الحرم الجامعي، والتي تبنى على قاعدة تواصلية هامة في تواصل الأزمات بشكل خاص والتواصل بشكل عام:
🔹🔹🔹”أنت تختلف معي، أنا أقبل الجلوس معك والنقاش والحوار، يمكن أن لا نتفق وليس شرطا أن نتفق، ليس ضروريا أن أقنعك بأفكاري، لكننا سننهي النقاش برفع برقية الوفاء للوطن ورموزه وشعاره، ونعيش تحت سقف وطن واحد في إطار القانون وفي ظل الاختلاف دون دعوات للحقد أو الحرب”.
هذه القاعدة تعتبرها حنا أرندت في كتابها “ما السياسة من صميم العمل السياسي”، فالسياسة هي شكل من أشكال تدبير التواصل، ولهذا هناك تخصص مهم اسمه التواصل السياسي، يجمع بين العلمين ويقود إلى نموذج تفاعلي رصين ورزين بين الناس وبين المؤسسات الفاعلة.
سؤال حول الفشل في فهم دور الجامعة بالمغرب؟
لا شك أن هناك عدم فهم لدور الجامعة في المجتمع بالمغرب ، “الجامعة” من فعل “جمع” والتفريق والبلطجة من تناقضات السلوك داخل الحرم الجامعي، بين الجدوى من الجامعة والمنتمين لها، مثلما إنها من تناقضات السلوك في السياسة، بين جدوى السياسة والمنتمين لها. فالسياسة كما تراها حنا أرندت هي مجال لتدبير الشأن العام، وليس فقط للتنافس الانتخابي أو لقضاء المصالح كما يراها ميكافيلي.
والجامعة هي فضاء لتدبير الشأن الفكري والمجتمعي من زوايا العلم والمعرفة، والتكريس لحوار الثقافات والأفكار والأديان من أهم ما يجب على الطلبة الإيمان به.
المغرب بلد الثقافات وبلد الاختلاف، وكما نقول دائما، الجامع بين هذا وذاك هو مؤسسة إمارة المؤمنين في الشق الديني، والدستور في الشق التشريعي والقانوني، والمؤسسات في الشق المؤسساتي والفاعلون على مختلف الأصعدة بتعبير علم السياسة، وشخص الملك في الشق المرتبط بمساطر ومسار القيادة على مختلف الجبهات، وأهمها تدبير الاختلاف. فلولا هذه المؤسسة، ونظير ما نراه من سلوكات وخاصة من “بلطجة” سواء في السياسة أو في الجامعة أو في المجتمع، لصرنا من أكثر الدول عرضة للحروب الأهلية. وهذه الحروب الأهلية كتعبير عن سلوك همجي خارج الحضارة لا تختلف عن الحروب الناعمة بين الطوائف في المغرب، رغم محاولة المؤسسة الملكية على رأس باقي المؤسسات في إطار “مغرب المؤسسات: قانونا وسلوكا ومذهبا وفلسفة دولة” لخلق التوازن المنشود بين هذا وذاك.
🔹طلبة تطوان والإساءة لرجل دولة إسمه العثماني
لا مجال للإطالة في خلفيات التعامل المشين من طرف بعض الطلبة القاعديين بتطوان مع سعد الدين العثماني، رجل الدولة المغربية، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية. الموضوع له علاقة مباشرة بفعل “التوقيع على وثيقة التطبيع مع الكيان المحتل” والمساهمة في تنزيل قرار دولة مع دولة معترف بها في الأمم المتحدة وباقتراح ووساطة أمريكية؛ وفي هذه الأمور لا مجال للعاطفة، هنا تحضر السياسة بثقلها وبمفهومها المبني على لغة المصالح. هذا السلوك يوضح جليا ضعف التكوين السياسي والتنشئة السياسية لهؤلاء الطلبة.
🔹الطلبة ببن التنشئة السياسية والتأطير الجامعي من خلال التفاعل مع التطببع
غير مقبول من الطلبة أن يكرسوا سلوك المقاهي والأحياء الهامشية التي لا تخضع بالضرورة لمنطق التأطير العلمي والجامعي والأكاديمي والسياسي، فتنتج سلوكات خارج التاريخ وخارج منطق التعايش بين البشر عموما وليس المغاربة فقط. أنت ترفض سلوك فاعل سياسي، ذلك حقك، لكن علمنا علم التواصل أن نضع كل سلوك تواصلي وردة فعل في سياقهما، لماذا تفصلون السلوك عن السياق؟ هل رفض إسرائيل جملة وتفصيلا أو عدم الاعتراف بها أمر منطقي؟ “هي حاضرة، بغيتِها أو كرهتي” هل سنتفاوض مع الفراغ؟ المنتظم الدولي والدول الرافضة للتطبيع يقولون إن في حالة تطبيق حل الدولتين واعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية عاصمتها القدس فإنها تقبل بتطبيع العلاقات، وهذا مستوى من مستويات التفاوض، أما المغرب فله فلسفته وهو حر فيها.
شغب الملاعب داخل الجامعة غير مقبول، فشباب المدرجات بمفهوم “الحركات الفرعية” بتعبير سوسيولوجي لا يمكن أن نقبل إسقاطه على شباب الجامعة؛ المفترض أن يكونوا مؤطرين معرفيا وسياسيًا في إطار الأحزاب التي ينتمون لشبيباتها. وهنا يحق لنا طرح السؤال: هل هو إعلان عن فشل الجامعة والسياسة معا في تأطير الشباب؟
🔹تواصل الحركات الطلابية وقصة شخصية من زمن حياتي الجامعية
هناك طرق أخرى للتعبير، افتح حلقية وناقش، أصدر بلاغا، أم أن ما قمتم به هو الأصح؟ أليست هناك آليات للتواصل داخل الحركات الطلابية تفي بالغرض؟ مثلما كان يفعل الرفاق أيام كنت طالبا في 2011 بجامعة الرباط، وعندما نتكلم عن رفاق 2011، فما أدراك ما رفاق الرباط في 2011، وعي طلابي راق جدا ومستوى رفيع، وما أدراك ما الحركات الطلابية في 2011 بالرباط، عشناها بمختلف ألوانها، من إشهار السيوف والمعاول من طرف البعض وتطويق الحي “بالبوليس” في ليلة لا تُنسى، إلى مختلف أشكال التعبير الحضاري، ونحن طبعا مع الفئة الثانية، فهذا مغرب اليوم وليس قريش زمن الجاهلية، هذه دولة وليست غابة. وكان لي شرف حضور تلك الحلقات سواء بكلية الآداب أو بالحي الجامعي السويسي أو بالحي الجامعي مولاي إسماعيل؛ كانت تلك الحلقيات “بمثابة أكورا فلسفية”، وكنت أحضر حلقات التجديد الطلابي وما أدراك ما التجديد الطلابي في تلك الفترة، وحلقات الطلبة الإسلاميين بمختلف تلويناتهم وحلقات طلبة الجنوب، كانت لدي ملاحظات كثيرة، كنت أختلف مع بعضهم جملة وتفصيلا، ولن أفصل فيما اختلفت فيه، لكن السؤال المطروح هنا: ما الذي يدفع طالبا لحضور حلقات نقاش بألوان مختلفة؟ كان البعض لا يقبل هذا الحياد، وكان البعض الآخر يعتقد أنني أنتمي لجهاز معين مهمته مراقبة ما يقوله الطلبة، “كنت أضحك كثيرا عندما يصلني هذا الكلام”، وكأنني مجبر على ارتداء قبعة ما، ولكن في الحقيقة كان القرار واضحا؛ ساهم فيه تأطير والدي حفظه الله، نظرا كونه رجل تعليم ودرس في جامعة تطوان أيام الثمانينيات والتسعينيات، ويعرف ما يعرفه عن الحركات الطلابية. فكنت ملتزما بتوجيه الوالد: أنا لا أنتمي لأي فصيل طلابي، لكنني أنتمي حسب قناعتي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، كوني طالبًا وكفى. وحتى هذا الأمر كنت أجد من يرفضه داخل مختلف الفصائل؛ هل هذا منطقي؟ كنت أتمنى حينها جمعهم جميعًا في اتحاد واحد، هو الاتحاد الموؤود لطلبة المغرب، بسلوك طلابي لا يخضع للمنطق.
🔹ما كرسته في حياتي الطلابية أن الجامعة للجميع والوطن للجميع
لنعد للسؤال المطروح: لماذا كنت محايدا وأحضر مع الجميع؟ أولًا لأنني طالب، وهذا حقي، وثانيًا لأنني كنت طالب علم النفس وبعدها طالب سوسيولوجيا بالكلية وبعدها طالب علوم الإعلام والتواصل بمعهد الإعلام والتواصل عموما والتواصل السياسي بصفة خاصة في سلك الماستر، وقبل هذه التخصصات بدأت مساري الجامعي بدراسة الفلسفة. هذه التخصصات لا يمكن أن تنتج فكرا عنصريا أو طائفيا لو درستها بوعي، أما إذا درستها بجهل وبهشاشة في التنشئة الأسرية والاجتماعية عموما فإنك تصبح ملحدا بعد أول يوم تدرس فيه الفلسفة وستجن عقليا وتضطرب نفسيا في أول يوم تدرس فيه علم النفس وستكره المؤسسات الاجتماعية والمجتمع برمته في أول يوم تدرس السوسيولوجيا وستحقد على بنية التواصل والصحافة في المجتمع في أول يوم تدرس فيه الصحافة أو التواصل، وستكره جميع السياسيين في أول يوم تدرس فيه التواصل السياسي والسياسة. لكنني آمنت بما قاله بول باسكون ومعه محمد جسوس عن المجتمع المغربي المركب، وآمنت بما قاله الجابري والعروي عن المغاربة في زوايا معينة، وعشقت نظريات التحليل النفسي عند فرويد، التي تحلل الصراع الفردي فتسقطه على الصراع المجتمعي لفهم هذه التناقضات بين النظريات العلمية في العلوم الإنسانية وبين تناقضات السلوك والممارسة والمجتمع؛ أما فن النواصل فمع هابرماس ومانوييل كاستلز وخاصة كتابه سلطة الإتصال او شبكات الإتصال، فتلك قصة أخرى،، ومن هنا ينطلق دور الطالب في فهم المجتمع من جهة ومحاولة المساهمة في تغييره “في الدوائر الضيقة المسموح بها منطقيًا” عن طريق ما تلقنه في الجامعة، أما لغة الشعارات الجوفاء فلم أؤمن بها قط، لقد كرست حياتي الطلابية في جانب معين لخدمة فكرة واضحة: الجامعة للجميع والوطن للجميع.
🔹ماذا فعلت في الجامعة كمبادرات طلابية ولماذا كانت ترفض من البعض؟ وماذا تعلمت خارج إطار الدرس الجامعي ؟
لدي تجارب متعددة في الجامعة، ومواقف ومبادرات ساهمت في خلق التوازن بين المختلفين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، حيث إنني كنت رئيسا لنادي ثقافي وبعده لنادي سوسيولوجي. لم يفهم البعض حينها أن غايته هي محاولة تدبير الاختلاف، وكان ذلك بمبادرة مني عكس ما كان يتهمني به البعض كوني مدفوعا من جهات معينة، فهمت لاحقا أن هذا أسلوب معتمد؛ التجييش والاتهام وخلط الأوراق من أساليب العقليات المريضة. كنت أنظم ندوات أجمع فيها أساتذة الدراسات الإسلامية بأساتذة علم الاجتماع وأســــاتذة الإعلام بطلبة الآداب، وأنظم ورشات لمن يهتمون بمراجعة الدروس وتطوير القدرات، وورشات في المسرح وأخرى لمن يهتمون بالموسيقى وأخرى لمن يهتمون بالمعرفة. كنت أحرص على إصدار عدد شهري من المجلة الحائطية بالكلية (الصحافة كانت وستبقى عشقي وانطلقت هذه العملية بثانوية علال الفاسي بطنجة). كنت أنظم معارض للطلبة التشكيليين، وأحرص على نشر قصائدهم بالمجلة، جمعت طلبة السوسيولوجيا المبدعين في كرة القدم وحرصت على مشاركتهم في دوري لكرة القدم، كنا ننظم جلسات لقراءة الكتب، وأحضر أنشطة ناد آخر خاص بالقراءة يؤطره الأستاذ عمر بنعياش كلما سمحت الظروف بذلك. كنا ننظم معارض للكتب بدعم من الكلية والجامعة بعدما آمنوا بما نقوم به، علما أن واجهوني بالرفض في البداية وكنت أجتمع مع الطلبة في الساحة وفي حديقة باب الكلية قبل أن أحصل على ترخيص استعمال القاعات والمدرجات. أحضرت رئيس الجامعة لحضور افتتاح أحد الأنشطة، وقال في كلمته إن ما أحضره هو ما كتب في المراسلة بشكل خاص وما سمعه عن النادي، الذي أصبح وللفترة تواجدنا بالكلية من أفضل النوادي بتاريخها.
كان ذلك بمثابة دليل بالنسبة لبعض التافهين كوني مجندا من الأجهزة لفعل ما أفعله—كيف يحضر رئيس الجامعة لافتتاح نشاط نادي طلابي؟ وما الغريب في ذلك؟ نحن طلبة وذاك رئيس للجامعة، تطوعت،رفقة طلبة اخرين، و لسنوات بمصلحة الشؤون الطلابية دون أن يطلب مني أحد ذلك، لأساعد الطلبة في التسجيل وفي الحصول على وثائقهم وفي القيام بمهام مع الموظفين لان الطلب كان اكبر من قدرة الموظفين نظير قلتهم، تعلمت الكثير في هاته التجربة، كان البعض يركز في انتقاده لنا على تشجيعنا لإدخال الموسيقى والفن بشكل عام للحرم الجامعي، لكنه في نفس اللحظة لم يكن يحضر ندواتنا العلمية وأنشطتنا الثقافية وما كان يشجعها.
إذا هؤلاء همهم الإقصاء وليس الانتقاد، وهنا بدأت أفهم هذا التناقض الذي تتوارثه الحركات الطلابية ولا تستطيع أن تجري نقدا ذاتيا لسلوكها وتفكيرها، وهذا بالضرورة راجع للتأطير العلمي من جهة، والسياسي من جهة ثانية، والأسري من جهة ثالثة؛ التربية مهمة، والجامعة هي فضاء للتربية والتعلم. وفي هذه التجربة تعلمت الكثير من المهارات خارج إطار الدرس الجامعي وأفادتني في مساري المهني بشكل كبير. إذا لماذا لا نرى أثرا لهذه الحركات الطلابية وتأثيرها على الطلبة كما استطعنا نحن بفكرنا المنفتح أن نؤثر؟ ألا يطرحون مثل هذه الأسئلة؟ والسؤال الأهم: لماذا يزرعون الخوف بين صفوف الطلبة؟ لماذا يخاف الطلبة عموما من هذه الفصائل وخاصة في بعض المواقع كفاس وأكادير وغيرهما؟
🔹استنتاج منهجي: علم لا ينتفع به.
وبالتالي وكاستنتاج منهجي بناء على المعطيات أعلاه وأدناه، وتفاعلا مع عنوان المقال، هناك علم لا ينتفع به لا في السياسة ولا في الجامعة بالمغرب للأسف. وقد علمتني الحياة أن العلم الحقيقي بالجامعة المغربية لن يعلمك أبدا حمل السلاح بمختلف أشكاله للتعبير عن نفسك وإنما سيعلمك حمل القلم وحمل الفكر، والعمل في إطار القانون، وفي إطار المؤسسات، وفي إطار الدستور، لمواجهة أي اختلاف دون تحويله بالضرورة إلى خلاف؛ ما المشكلة في الاختلاف؟ وهل يتصور إسلامي أو يساري أن أحدهما بإمكانه إقصاء الطرف الثاني بأي شكل فقط لأنه يختلف معه؟
🔹الطلبة والعثماني وسياق التوقيع على وثيقة للتطبيع
ما معنى أن ترفع شعار “فلسطين قضية وليست حملة انتخابية”؟ ما هذا العبث؟ أي انتخابات سيدخلها العثماني؟ ألا يكفيه ما يعانيه من إخوانه في الحزب من تهميش لا يستحقه؟ ألا تعرفون حقا أن قرارات الدولة اتفقنا معها أو اختلفنا معها، فيجب أن نحترمها في إطار السلوك ونعبر عن رفضنا لها في إطار مساحات التعبير التي تكفلها الدولة نفسها؟ لماذا لا نفهم أن لكل مقام مقال؟ العثماني نفسه خرج مع يونس مسكين في “ضفاف الفنجان” على قناة صوت المغرب وقال: “هناك قرارات سواء اتفقت معها أو اختلفت معها تبقى قرارات دولة.. وهناك قرارات يمكن أن نقول إنها كانت خاطئة”. ألم يقل بنفسه إنه كتب قبل 25 عاما أنه ضد “ما وقع عليه”؟ فلماذا هذا الخلط وهذا التحامل على الرجل؟ لماذا نخون بعضنا بل نعشق التخوين والاتهام؟ هل هي سادية اجتماعية على وزن السادية النفسية؟
🔹إلى حزب العدالة والتنمية: حان الوقت لرد الإعتبار للعثماني
أما العدالة والتنمية فحان الوقت ليكسروا جدار التجاهل والصمت والنكران. أخطأ العثماني أو لم يخطئ، أنتم تعرفون الحقيقة أكثر مني ومن طلبة تطوان، لكن التجييش على الرجل في المؤتمر الأخير للحزب وخاصة في الدوائر الضيقة للنقاش ورفض حضوره الرمزي، ساهم فيما وصلنا إليه وعليكم “والله أعلم” تصحيح المسار. ولأن بنكيران لا يقبل من ينصحه لا بمنطق التخصص ولا بمنطق آخر، قد يرفض هذا التوجيه، لكنني مصر عليه: “أ السي بنكيران” عليك أن تسمع للمستشارين والمتخصصين في التواصل السياسي، وإلا ما الجدوى من هذا التخصص في الجامعة؟” وقد سبقك الداودي في تصريح مع الرمضاني لهذا الأمر، عندما اعترف أنه لا يهتم بـ”رجال وسيدات التواصل”، وهذا عيب؛ عندما يبخس السياسي عمل الجامعي فعلى الوطن السلام. الجامعة كما قال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في أحد التصريحات التي نقلناها عنه في جريدة مغرب بريس تيفي مؤخرا، هي مختبر لتزويد المجتمع والفاعلين بالمعرفة لتعزيز تقدم البلاد، وعلى السياسي أن يعيد الاعتبار لعمل الجامعة في مختلف التخصصات لا أن يساهم في تبخيسها، وبدل الاستعانة بمستشارين متخصصين نجد من لا علاقة لهم بالمجال يدبرون شؤون التواصل، فتحدث الكوارث في التواصل وهي “على أفا مين يشيل” كما يقول الإخوة في مصر.
🔹أنا مع الدولة سياسيا وضد القرار المعلوم إنسانيا
خلاصة القول: أنا شخصيا مع قرارات الدولة في القضايا المصيرية، لأنني أعرف ومن منطلق دراستي لعلم الدولة في نظريات مختلفة سواء في علم الاجتماع أو السياسة، أعرف أن للدولة حسابات أخرى ومنطقا آخر، ومن باب الأدب: “واش أنا غانفهم حسن من الدولة … الدولة تتحمل مسؤوليتها وسخر الله أمرها وأمرنا..بعضهم يفشل حتى في النجاح والحصول على شهادته الجامعية ويناقش وينتقد الدولة… كون تحشم”، ولكن من حقي التعليق والرفض ولكن بأدب وفي إطار ما يسمح به فضاء التعبير وحسب السياق.
🔹مستويات النقاش في ” قرار الدولة التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي”
هنا على من يقرأ أن يركز جيدا جدا، وأحييك على تشجيعك للكتابة في زمن الكآبة والصحافة في زمن السخافة، فأمة إقرأ لم تعد تقرأ جملة فما بالك بمقال طويل كهذا، لنمر، في هذا القرار “التطبيع” هناك مستويات، مستوى سياسي ودبلوماسي، ومستوى إنساني وقيمي؛ في المستوى الأول مع، في المستوى الثاني ضد. لا أعتقد أن تعبيري عن هذا الموقف سيزعج الدولة، فالدولة بحكم أنها دولة تعرف أنها تضم على أرضها من يتفق مع بعض سياساتها ومن لا يتفق.
🔹القضية الغلسطينية قضية إنسانية تجاوزت السياسة
القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية تتجاوز حسابات السياسة، ما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء استمرار العدوان الصهيوني لم تعد السياسة قادرة على تدبيره، ولهذا نجد أن السلوك السياسي للدول بما فيها الدول المطبعة يختلف عن موقفها الإنساني، فللسياسة حساباتها وللدبلوماسية حساباتها أما الإنسانية فتتكلم لغة واحدة.
🔹أمريكا والخلط بين السياسي والإنساني
أمريكا مثلا تخلط بين السياسي والإنساني ولم تعد قادرة على الفصل بينهما، فحين يصوت مجلس الأمن على قرار وقف إطلاق النار وبرفضه الفيتو الأمريكي، فهنا حديث عن مؤشر واضح لما نتحدث عنه. أما المغرب فهو واضح، إنسانيا أدان ويدين العدوان، بلاغ الأغلبية الحكومية الأخير مثلا أدان بشكل صريح الاعتداءات، والخارجية عبر وزيرها ناصر بوريطة تدين، والملك نصره الله وفي مناسبات دبلوماسية دولية يدين،
أما سياسيا هناك نقاش، وهناك مجالات للتفاوض، بشكل منطقي ودون مزايدات. هذا ليس مجالا للمزايدات أو تقديم مبادرات غير قابلة للتحقق، أو دغدغة العواطف بالكلام اافارغ الذي سمعناه منذ ولادتنا.
🔹في السياسة هناك منطق اخر
هذا هو دور السياسة، استحضار لغة المصالح ولغة المنطق في التفاوض، والتفاوض أحسانا يمكن أن يكون مع العدو، وغالبا هو كذلك، أما ااصديق والحبيب والشريك والحليف فهؤلاء شركاء في النجاح واامبادرات الخلاقة، أما العدو غنحتاج معه لمستويات أعلى من الذكاء العاطفي والسياسي لنصل معه لتحقيق هدف او مطلب او غاية، أما أن نرفض جملة وتفصيلا سلوكا سياسيا له خلفياته بمرجعية نقول إنها سياسية داخل تنظيمات طلابية فهذا يعني أن هذه التنظيمات لا تفهم ما معنى السياسة عموما وما دور الأجهزة الدبلوماسية بصفة خاصة، فرقوا بين مستويات النقاش والسلوك رحمكم الله.
🔹المغرب رئيس لجنة القدس: هل الرسالة واضحة؟
المغرب رئيس لجنة القدس؛ التطبيع سلوك سياسي وعلينا ألا نخرجه عن هذا الإطار ونحاول أن نبني علاقات للعشق والغرام مع الكيان. الكيان كتب لنفسه تاريخا أسودا مقيتا منبوذا تجاوز ما كنا نرفضه بخصوص رواياتهم عن تعامل هتلر معهم، نحن نرفض أن يُقتل الإنسان بغير ذنب، الحروب يجب أن تُخاض بأخلاق بين الجيوش، المدنيون لا علاقة لهم لا بالسياسة ولا بالجيوش، والكيان خلط جميع الأوراق، ومع ذلك نحن مستعدون لإخباره بذلك كلما سنحت لنا الفرصة.
🔹التطببع المغربي بين السياسي والإنساني
التطبيع المغربي لن يكون تطبيعا إنسانيا معكم، كيف تتحدثون عن السلام وصواريخكم تقتات من دماء الاطفال والنساء والابرياء؟ أوقفوا الحرب أولا وبعدها يمكن أن نتحدث عن السلام، هو تطبيع سياسي ودبلوماسي، له مصالح متبادلة، ومن بين هذه المصالح الدفاع عن القضية الفلسطينية حسب ما هو متاح في حضور ممثلي الكيان. في وثيقة التطبيع التي وقعها العثماني هناك تعبير واضح عن هذا؟ ألَا تقرأون؟ فقط على الكيان أن يكون مستعدا لهذا النقاش، وأنا أعرف أنهم ونظرا لمؤشرات كثيرة لا يقبلونه، يرفضون نعتهم بما فيهم، وهناك من يروج في المغرب لأطروحات براءتهم من الإجرام الواضح، حتى الدولة بمختلف أجهزتها لا تفعل ذلك، وهذا هو الأخطر، أما توقيع العثماني فهو سلوك طبيعي في إطاره وسياقه، سلوك رجل دولة وجب توقيره واحترامه، كما قال الحسن الثاني رحمه الله ” وليتو خفاف”، ووانا سأوقل لكم يا مثقفي اامستقبل” ما لكم كيف تحكمون… كونو تحشمو”. والسلام.