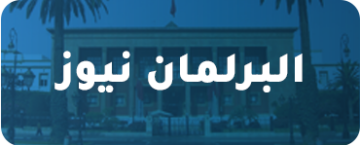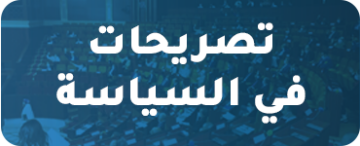اللغة العربية بين القداسة والجدارة: سوسيولوجيا الصراع الرمزي على لغة التدريس في المجتمعات العربية
هشام بوقشوش*|في المجتمعات العربية الإسلامية، تحتل اللغة العربية موقعا مركزيا، ليس فقط بوصفها أداة للتواصل، بل باعتبارها حاملة لهوية دينية وتاريخية وثقافية عميقة. وقد ساهم هذا الامتداد الرمزي في تحميلها أبعادا إيديولوجية تتجاوز وظيفتها البيداغوجية الصرفة. وفي ظل الصراعات الهوياتية والتربوية المعاصرة، تبرز إشكالية تدريس العلوم باللغة العربية باعتبارها حلبة يتقاطع فيها الديني بالعلمي، والرمزي بالنفعي، مما يطرح تساؤلات حارقة حول التفوق المعرفي والاستقواء الهوياتي من خلال اللغة.

اللغة العربية: بين الرمزية الدينية والوظيفة التعليمية
تحظى اللغة العربية في السياق الإسلامي بمكانة مقدسة، فهي لغة القرآن الكريم، ولغة الشعائر، ولغة الخطاب الديني. وقد أفضى ذلك إلى تمثل اجتماعي يرى فيها لغة “الحق” و”الهوية”، لا لغة “العلم” و”المنفعة”. هذا التمثل غالبا ما يؤدي إلى نوع من المفارقة السوسيولوجية، فاللغة التي تحظى بأعلى درجات القداسة الرمزية، تعاني في الآن ذاته من تراجع على مستوى الاستعمال العلمي في المؤسسات التعليمية، وخاصة في تدريس العلوم الدقيقة والتقنيات الحديثة.
وقد حللت أدبيات سوسيولوجيا اللغة مثل أعمال بيير بورديو هذه الظاهرة من زاوية العنف الرمزي، إذ تفرض لغات معينة كأدوات للهيمنة على الحقول المعرفية، فيما يتم تهميش لغات أخرى بالرغم من شرعيتها الثقافية والاجتماعية.
رأس المال اللغوي والاستقواء الرمزي
في ضوء تحليل بورديو لمفاهيم رأس المال الرمزي ورأس المال اللغوي، يمكن فهم الاستقواء الديني عبر اللغة العربية كأداة لإعادة إنتاج الهيمنة الرمزية. فإتقان العربية الفصحى لا يعد مجرد مؤشر معرفي، بل علامة على الانتماء إلى فضاء ديني “نقي”، مقابل اتهام من يتكلم بلغات أجنبية بـالاغتراب أو التغريب. لكن من جهة مقابلة، يتم أحياناً توظيف هذه اللغة ذاتها لتأكيد تفوق أخلاقي أو هوياتي في الفضاء المدرسي، حيث يربط بعض التلاميذ بين استعمالهم للعربية وبين تمثلهم للدين والانضباط، مما يجعل اللغة أداة للتمايز والسلطة الرمزية، وليست فقط وسيلة لفهم المعارف.
الإيديولوجيا التربوية والصراع على لغة التدريس
ترتبط اللغة العربية داخل الأنظمة التعليمية العربية بمحددات إيديولوجية متشابكة. فالتيارات المحافظة أو الإسلاموية ترى في اعتماد العربية لغة موحدة للتدريس نوعاً من استعادة “الهوية الضائعة”، في حين ترى التيارات الحداثية والبراغماتية أن الانفتاح على اللغات الأجنبية شرط ضروري للتقدم العلمي.ينتج عن هذا التقاطع صراع لغوي يعكس رهانات سياسية وثقافية، طروحات أفرزت تضادات بين كون المدرسة فضاء للحفاظ على الذاكرة الدينية-اللغوية وبين كونها أداة لتكوين الرأسمال البشري المعولم.
ويزداد هذا الصراع تعقيدا حين يحمل الطفل بمهمّة الدفاع عن “الهوية” عبر اللغة، عوض أن يمنح الأدوات الفعالة للنجاح العلمي في عالم متعدد اللغات.
التفوق الدراسي والتمايز الطبقي – اللغوي
يرتبط التفوق الدراسي اليوم في المجتمعات العربية ارتباطا وثيقا بإتقان لغات أجنبية، خاصة الفرنسية والإنجليزية، حيث ترتبط هذه اللغات بالولوج إلى المدارس العليا، وسوق الشغل، وفرص الهجرة أو الارتقاء الاجتماعي.
في هذا السياق، تتحول اللغة إلى أداة لإعادة إنتاج التفاوت الطبقين كون أبناء النخبة يتقنون اللغات الأجنبية ويتفوقون في المواد العلمية، في حين أن أبناء الطبقات الشعبية يتعلمون العلوم بلغة عربية “مفككة”، دون أدوات فعالة لمسايرة مناهج عالمية.يؤدي ذلك إلى فجوة معرفية عميقة، تقابل أحيانا برد فعل إيديولوجي من طرف الفئات المتضررة، يعيد تأكيد “الاستقواء الديني” على “التفوق العلمي” كنوع من المقاومة الرمزية.
نحو لغة متصالحة مع المعرفة
لا يمكن حسم الصراع اللغوي والتربوي في المجتمعات العربية دون الاعتراف بتعقيد الوضعية اللغوية، والبعد الإيديولوجي الذي يحكم النقاش حول اللغة. فالتفوق المعرفي لا ينبغي أن يعارض الرمزية الثقافية والدينية، ولكن لا يجوز أيضا أن يختزل التعليم في معركة هوية.المطلوب ليس التخلي عن العربية، ولا فرض اللغات الأجنبية، بل بناء سياسة لغوية علمية، منفتحة، ومتوازنة، تعترف بأن لكل لغة وظيفتها وسياقها، وأن رأس المال اللغوي يجب أن يوزع بعدالة، لا أن يكون أداة لاحتكار النخبة أو رمزية القداسة.
*د. هشام بوقشوش / باحث في علم الاجتماع