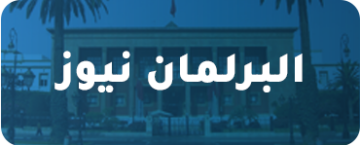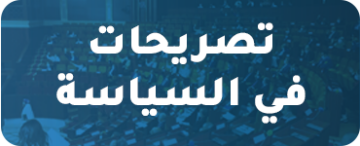الجامعة المغربية بين سطوة القانــــون ونــداء الهوية..حيث يصاغ مصير الوطن
أليست الجامعة مهددة بأن تصبح بين مطرقة الحرية النظرية وسندان الرقابة العملية؟
■ ذ. منير الكماني مهندس مدني، كاتب في مجلة ناطقة بالألمانية
ألمانيا| ليست الجامعة مجرد بناية شاهقة ولا مدرجات مكتظة بالطلبة، بل هي المرآة التي تعكس ملامح الأمة، والوعاء الذي يحفظ ذاكرتها، والورشة التي تُصاغ فيها ملامح المستقبل. كل إصلاح يطالها إنما يطال عمق المجتمع نفسه. لذلك، لم يكن غريبا أن يعود المغرب، بعد ربع قرن من اعتماد القانون 01.00، إلى مراجعة شاملة لقانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، مستنداً إلى القانون الإطار 51.17 وتوصيات النموذج التنموي الجديد. غير أن الأسئلة الكبرى تظل معلقة: هل تكفي النصوص وحدها لترميم أعطاب جامعة أنهكها الزمن؟ أم أن الإصلاح سيبقى حبيس الأوراق ما لم يتجذر في الثقافة الجامعية وفي وعي الفاعلين؟
بين النص الحالم والواقع المقاوم
ينص مشروع القانون على أن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي هو:
“استثمار منتج في الرأسمال البشري الوطني وإسهام في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة” (المادة 3 [مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي، 21 يونيو 2021: “تقوم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على تحقيق التوجهات العامة للدولة في هذا المجال، باعتبار أن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار استثمار منتج في الرأسمال البشري الوطني وإسهام في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة.”]).
هذا التصور يعكس طموحا لوضع الجامعة في صلب المشروع المجتمعي. بل ويذهب أبعد حين يقر باستقلالية الجامعات، إذ تنص المادة 7 على:
[“تعتبر الجامعات مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية، كما تتمتع بالاستقلالية العلمية والبيداغوجية والثقافية وحرية المبادرة في مجال الإبداع والابتكار والتميز.”].
ويمنحها إطارا تعاقديا مع الدولة يحدد المسؤوليات ويقيّد الأداء. لكن خلف هذا الأفق المشرق، تختبئ معضلة أساسية: النصوص لا تنفذ نفسها. فكيف ستتوازن هذه الاستقلالية مع الوصاية المالية والإدارية التي أبقاها المشروع للدولة، حيث تنص المادة 8 على:
[“تخضع الجامعة العمومية لمراقبة مالية مواكبة من قبل الدولة تهدف إلى التأكد من مطابقة تسييرها للمهام والأهداف المرسومة لها، وتقدير أدائها المالي وسلامة الأعمال التي تقوم بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.”].
أليست الجامعة مهددة بأن تصبح بين مطرقة الحرية النظرية وسندان الرقابة العملية؟
الفاعل الجديد
من أبرز ما حمله النص فتح المجال لمؤسسات خاصة وأخرى غير ربحية ذات نفع عام. فقد نصت المادة 11 على:
[“تحدث المؤسسات الخاصة للتعليم العالي بمبادرة من كل شخص اعتباري أو ذاتي من أشخاص القانون الخاص.”]،
كما أوضحت المادة 12 أن هذه المؤسسات تشمل:
[“جامعات خاصة تتكون من مؤسسات تابعة لها؛ كليات خاصة؛ مدارس خاصة؛ معاهد خاصة.”].
وألزمت المادة 13 بترخيص مسبق بقولها:
[“تخضع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في إحداثها وتنظيمها وتسييرها لنظام الترخيص الذي تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.”].
أما المادة 14 فقد جاءت بجديد نوعي:
[“يمكن إحداث مؤسسات للتعليم العالي غير ربحية ذات النفع العام بين أشخاص القانون العام أو بين أشخاص القانون العام والقانون الخاص، قصد الاستجابة للأولويات الوطنية في مجال البحث العلمي.”].
وحتى تشجع الدولة هذه المشاريع، نصت المادة 87 على:
[“يوضع بموجب قانون المالية نظام جبائي خاص من أجل التشجيع على إنجاز مشاريع وبرامج للاستثمار في التعليم العالي، من قبل كل شخص ذاتي أو اعتباري. وفي هذا الإطار تعمل الدولة على قرار تحفيزات جبائية ومالية لفائدة هذه المشاريع والبرامج.”].
خطوات تبدو واعدة لكنها تثير التساؤل: هل ستظل العدالة الاجتماعية مصونة أمام تمدد القطاع الخاص، أم أن الجامعة ستنزلق إلى سوق مفتوح للعلم؟
بين رقابة الأرقام وحرية الأفكار
لضمان الجودة، تنص المادة 93 على أن:
[“تقوم الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي بإنجاز تقييمات دورية لمؤسسات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمختلف أصنافها، وترفع بشأنها تقارير إلى السلطة الحكومية المعنية، وتنشرها بجميع الوسائل المتاحة.”].
لكن الجودة لا تختزل في تقارير دورية ولا في مؤشرات كمية؛ إنها ثقافة لا تزدهر إلا بموارد بشرية محفزة وتمويل قار وبنية حديثة. وهنا يظل السؤال معلقاً: كيف نحفّز الأستاذ الباحث على العطاء في غياب ظروف مادية ومعنوية مستقرة؟
رهانات الإصلاح في امتحان الهوية
ما يميز هذا المشروع أنه لا يقف عند التنظيم الإداري، بل يلامس سؤال الهوية الجامعية. فقد نصت المادة 60 على:
[“يمكن لكل جامعة أو أي شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص إحداث مؤسسات رقمية متخصصة أو متعددة التخصصات، تعترف بها الدولة وفق دفتر للتحملات.”].
كما أقرت المادة 63 أن أنماط التكوين تشمل:
[“التعليم الحضوري؛ التعليم عن بعد؛ التعليم المزاوج بين الحضوري وعن بعد؛ التعليم بالتناوب؛ وأنماط تكوين أخرى يحددها نص تنظيمي.”].
هذا الانفتاح على الرقمنة والتكوين المتنوع ضروري، لكنه يطرح سؤال التوازن بين الانخراط في العولمة وحماية الذات من الذوبان.
نجاح على المحك
• أي ضمانات لحماية التعليم العمومي من التهميش أمام تمدد القطاع الخاص؟
• هل الاستقلالية المعلنة للجامعات حقيقية أم مجرد شعار محكوم بقبضة الدولة؟
• ما مصير البحث العلمي إذا ظل رهين الاعتمادات المحدودة والشراكات الظرفية؟
• كيف نحول النصوص القانونية إلى واقع ملموس يغيّر حياة الطالب والأستاذ معاً؟
الحلول لا تكمن فقط في الإضافات التشريعية، بل في هندسة ثقة جديدة بين الدولة والجامعة، وبين الجامعة والمجتمع. لا إصلاح بلا تمويل كافٍ، ولا جودة بلا تحفيز للطاقات، ولا جامعة حقيقية بلا حماية لهويتها وخصوصيتها.
القانون تحت مجهر الميدان
إن مراجعة القانون المتعلق بالتعليم العالي ليست مجرد تعديل تشريعي، بل هي امتحان وطني لقدرة المغرب على جعل الجامعة رافعة للتنمية. الإصلاح الحقيقي لن يُقاس بعدد المواد، بل بمدى قدرة الجامعات على إنتاج المعرفة، وباحترامها لكرامة الطالب والأستاذ، وبمدى حضورها كقوة اقتراحية في المجتمع.
ويبقى السؤال الذي يجب أن يلاحقنا جميعاً: هل سنبني جامعة تُشبه وطننا في أصالته وتطلعاته، أم سنستورد جامعة تُشبه الآخرين فنفقد أنفسنا ونحن نلهث خلفهم؟