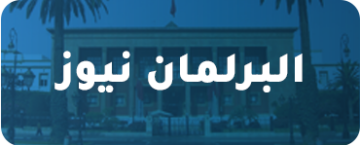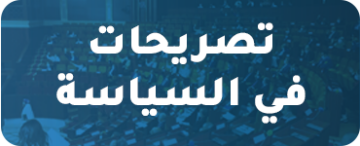حرية التعبير والمقدس:قراءة نقدية لحالة ابتسام لشكر
تذهب النظرية النقدية إلى أن الفعل الرمزي (مثل ارتداء قميص بعبارة مستفزة دينيا) لا يقرأ في فراغ، بل في سياق اجتماعي حيث الرموز الدينية تمثل رأسمالا رمزيا عالي القيمة، وفق تعبير بورديو.
■ د. هشام بوقشوش|باحث في علم الاجتماع
الرباط| تشكل واقعة ابتسام لشكر، التي أثارت موجة واسعة من السجال الحقوقي والسياسي في المغرب، مدخلا تحليليا لفهم ديناميات الصراع المعاصر بين حرية التعبير وحماية المعتقد الديني، خاصة حين تتحول الرموز المقدسة إلى موضوع لتدخل المجال العمومي عبر وسائط الإعلام الرقمي.من منظور النظرية النقدية الحديثة، كما تطورت مع هابرماس وفريزر ونيغت، لا يمكن قراءة هذه الحادثة في إطار قانوني صرف، بل باعتبارها لحظة تكثيف لصراع رمزي على تعريف حدود المجال العمومي ذاته: من يملك حق الكلام؟ وما هي أشكال التعبير المشروعة؟ وكيف يتم توزيع رأس المال الرمزي بين الفاعلين الاجتماعيين؟
1. الفضاء العمومي والتنازع على الشرعية
وفقا لهابرماس، الفضاء العمومي هو ميدان تداولي تنتج فيه الآراء عبر النقاش الحر، لكن في السياق المغربي، يظل هذا الفضاء مؤطرا بتوازنات قوى غير متكافئة، حيث يهيمن خطاب ديني محافظ مدعوم بمؤسسات الدولة القانونية والرمزية، في مقابل خطاب حقوقي-علماني يسعى لفرض شرعيته من خلال التذرع بالمواثيق الدولية. حادثة لشكر تكشف عن تصدع في الفضاء العمومي، إذ تحولت إلى “حدث محفز”دفع الأطراف المختلفة إلى إعادة ترسيم حدود المقبول والمرفوض في التعبير.
2. إنتاج الإساءة: من الفعل الفردي إلى التمثيل الجمعي
تذهب النظرية النقدية إلى أن الفعل الرمزي (مثل ارتداء قميص بعبارة مستفزة دينيا) لا يقرأ في فراغ، بل في سياق اجتماعي حيث الرموز الدينية تمثل رأسمالا رمزيا عالي القيمة، وفق تعبير بورديو.
ما قامته لشكر أعيد تأويله جماعيا، فتحول من فعل فردي إلى إساءة جمعية عبر آلية التأطير الإعلامي في الصحافة ووسائل التواصل، مما ضاعف من شدته الرمزية وأدخله في مسار الصراع الثقافي. تشرح النظرية البورديوية مفهوم الرأسمال الرمزي، وهو القوة الاجتماعية المتمثلة في القدرة على تعريف ما هو مشروع أو مقبول ضمن مجال معين. الرموز الدينية في المجتمع المغربي تمثل رأس مال رمزي عالي القيمة؛ أي أن أي مساس بها يقرأ كتهديد للهوية الجمعية والنظام الرمزي السائد. من هذا المنظور، الفعل الفردي لشكر لا يفهم بمعزل عن شبكة العلاقات الاجتماعية والرمزية التي تمنح للمقدس مكانة فائقة في ترتيب القيم.
3. حدود الحرية في الثقافة السياسية المغربية
تقوم النظرية النقدية الحديثة على فضح الحدود غير المعلنة للحريات في المجتمعات الديمقراطية الناشئة، حيث تستدعى حماية المقدسات كأداة لضبط المجال العمومي، ليس فقط بدافع ديني، بل كآلية لإعادة إنتاج السلطة الرمزية للدولة والتيارات المحافظة.في هذه الحالة، تستخدم تهمة “ازدراء الأديان” كـقانون إطار يضبط الخطاب العام ويعيد رسم ملامح المشروعية الاجتماعية، وهو ما يخلق مفارقة: النص القانوني قد لا يجرم بدقة هذا الفعل، لكن الثقافة السياسية تفرض عقوبة رمزية واجتماعية قد تفوق العقوبة القانونية.
4. الهيمنة والمقاومة
وفقا لدوركهايم، المقدس ليس مجرد معتقد شخصي، بل عنصر تنظيمي للهوية الجمعية. أي فعل مسيء له يفهم بوصفه اعتداء على الجماعة بأكملها، وليس فقط على الفرد المعتقد. بالتالي، الجدل حول مشروعية الفعل ليس نقاشا قانونيا صرفا، بل صراعا رمزيا على إعادة تعريف القيم والحدود الاجتماعية.
استنادا لغرامشي، يمكن النظر إلى خطاب لشكر بوصفه محاولة لمقاومة الهيمنة الثقافية، حتى وإن اتخذت شكلا صادما للمشاعر الدينية. لكن في المقابل، رد الفعل المحافظ –مدعوما بالإطار القانوني– يندرج ضمن آليات إعادة إنتاج الهيمنة، عبر ضبط الخطاب الخارج عن المألوف وإعادته إلى حدود النظام الرمزي السائد.هذا الصراع يكشف عن طبيعة الحرية كحقل نزاع، حيث تفهم لا كحق مطلق، بل كإمكانية مشروطة بقدرة الفاعل على تحدي بنى السلطة دون التعرض للإقصاء أو التجريم.
5. إعادة تعريف الإساءة في العصر الرقمي
في سياق الإعلام الرقمي، يصبح الحدث المحلي سريع العبور نحو المجال العالمي، ما يضاعف من حساسيته ويزيد من احتمال تأويله في اتجاهات متضادة.النظرية النقدية هنا ترى أن “الإساءة” لم تعد فقط خطابا مباشرا، بل نتيجة تفاعل مركب بين نية الفاعل، وبنية الفضاء العمومي، وآليات الانتشار الإعلامي التي قد تحول المعنى وتعيد تشكيله وفق مصالح القوى المتصارعة.
الانبعاث المتجدد للصراع بين الحداثيين والمحافظين:
أثارت الحادثة، نقطة تلاقي للنزاعات الثقافية والسياسية في المجتمع المغربي، إذ تبرز الانقسام العميق بين تيارات الحداثة التي تنشد توسيع هامش حرية التعبير والفردانية، والتيارات المحافظة التي تعتبر حماية المقدسات الدينية جزءا لا يتجزأ من الهوية الجمعية واستقرار النظام الرمزي.
من منظور سوسيولوجي نقدي، الفعل الفردي لشكر لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق الاجتماعي والثقافي الذي يتحرك فيه. إذ يشكل المجال العمومي المغربي، وفقا لهابرماس، فضاء لتداول الآراء والحوار، لكنه أيضا حقل تصادم بين مرجعيات متعارضة، حيث تتشابك القوانين الوطنية، التقاليد الدينية، والقيم الحداثية في صراع دائم لتحديد ما هو مشروع وما هو محظور.وهكذا، يتحول الفعل الفردي إلى حدث رمزي مركزي يعيد إنتاج الصراع بين الحداثيين والمحافظين، إذ يرى الطر الأول في التعبير عن الذات حقا مشروعا حتى لو كان استفزازيا، بينما يعتبر الطرف الثاني أن المقدس يمثل حدودا لا يجوز تجاوزها حفاظا على الانسجام الاجتماعي والثقافي.
الإعلام الرقمي لعب دورا محوريا في تكثيف هذه التضادات، حيث يصبح الفعل الفردي على الفور موضوعا عاما، يعاد تأويله وتوظيفه في اتجاهات متعارضة، مما يحوّل الحدث المحلي إلى ساحة صراع رمزي واسع. من هذا المنظور، لا تكمن أهمية الحادثة في محتواها فقط، بل في قدرتها على إعادة تعريف الحدود الرمزية للمجال العمومي وإظهار كيفية تفاوض المجتمع على مشروعية الفعل.
التضاد السوسيولوجي هنا يتجلى في مواجهة قيم الفردانية والحرية الشخصية مع قيم الانتماء الجماعي والقداسة الدينية، وهو تضاد يعكس طبيعة المجتمع المغربي كمجتمع متأرجح بين الحداثة والتقليد، بين الحقوق الفردية والالتزامات الجماعية. وعليه، يصبح النقاش حول الفعل الفردي لشكر مؤشرا على صراع أعمق حول المشروعية والهيمنة الرمزية وإعادة إنتاج الهوية الجمعية.
حالة ابتسام لشكر ليست مجرد حادثة معزولة، بل حدث جدلي يعكس توترات أعمق في الثقافة السياسية المغربية بين مرجعيات حقوقية كونية وأخرى دينية-محافظة محلية. من منظور النظرية النقدية الحديثة، هذه التوترات لا تحسم عبر النصوص القانونية وحدها، بل عبر صراع مستمر على تعريف المجال العمومي وإعادة توزيع رأس المال الرمزي بين القوى الاجتماعية.إنها تذكرنا بأن حرية التعبير ليست مساحة متاحة للجميع بالتساوي، بل ميدان تفاوض وصراع، تتحدد حدوده وفق علاقات القوة السائدة، حيث كل إساءة محتملة تصبح مرآة للبنية العميقة للصراع الثقافي في المجتمع.
حادثة ابتسام لشكر تمثل ميدانا للتفاوض المستمر بين الحرية الفردية وحماية المقدس، وهي تجسد صراعا على إعادة تعريف المجال العمومي والحدود الرمزية المقبولة. المشروعية القانونية للفعل ليست ثابتة، بل تتشكل ضمن علاقات القوة الاجتماعية والثقافية، حيث تتداخل القوانين مع الأعراف والتمثلات الرمزية. من منظور سوسيولوجي نقدي، المقدس ليس مجرد معتقد شخصي، بل عنصر مركزي لإعادة إنتاج الهوية الجمعية، ما يجعل أي نقد له قضية سياسية وثقافية بامتياز، ويحوّل النقاش حول الفعل الفردي إلى حقل جدلي يعكس صراع الحداثة والتقليد، الفرد والمجتمع، الحرية والمسؤولية.