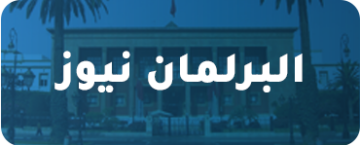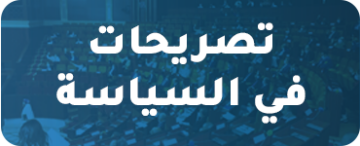الاغتصاب بمؤسسةالمخيم : تفكيك سوسيولوجي نقدي
الواقعة لم تقرأ بنفس الكيفية، إذ يرى البعض أنها مجرد “انحراف فردي شاذ”، يعالج عبر العقاب القانوني للفاعل. بينما تذهب مقاربة أخرى، أكثر نقدية، إلى اعتبار الحادثة نتاجا بنيويا لاختلالات متراكمة داخل قطاع التخييم: ضعف تكوين المؤطرين، غياب آليات انتقاء صارمة، هشاشة الرقابة من قبل الوزارة الوصية، وتواطؤ أو عجز الجامعة الوطنية للتخييم باعتبارها شريكا في التدبير.
■د. هشام بوقشوش باحث في علم الاجتماع
الرباط| تعتبر المخيمات الصيفية في المغرب فضاءات اجتماعية-تربوية يفترض أن تؤدي وظائف متعددة: التنشئة الاجتماعية، التربية على المواطنة، وتوفير الحماية النفسية والجسدية للأطفال. فهي فضاءات داعمة للأسرة والمدرسة في التنشئة الاجتماعية، يتعلم فيها الطفل قيم التعاون، الانضباط، والاندماج في الجماعة. غير أن حادثة اغتصاب طفل بأحد هذه المخيمات هزت الثقة في هذه المؤسسة، وطرحت على السطح إشكالات معقدة تتجاوز الواقعة الفردية لتلامس البنية العامة التي تدبر بها الدولة والمجتمع المدني قضايا الطفولة والشباب.
الواقعة لم تقرأ بنفس الكيفية، إذ يرى البعض أنها مجرد “انحراف فردي شاذ”، يعالج عبر العقاب القانوني للفاعل. بينما تذهب مقاربة أخرى، أكثر نقدية، إلى اعتبار الحادثة نتاجا بنيويا لاختلالات متراكمة داخل قطاع التخييم: ضعف تكوين المؤطرين، غياب آليات انتقاء صارمة، هشاشة الرقابة من قبل الوزارة الوصية، وتواطؤ أو عجز الجامعة الوطنية للتخييم باعتبارها شريكا في التدبير.
من منظور سوسيولوجي، تكشف هذه الحادثة عن أزمة ثقة مزدوجة: ثقة الأسر في المؤسسات الحاضنة لأبنائها، وثقة المجتمع في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في مجال حماية الطفولة. إنها ليست مجرد جريمة جنسية ضد قاصر، بل واقعة كاشفة لخلل في علاقة الدولة بالمجتمع المدني، حيث يجري تفويض مهام التربية والحماية لجمعيات لا تتوفر دائما على الكفاءات والموارد، مما يفتح المجال أمام ممارسات خطرة.
كما أن الفضاء التخييمي، الذي يفترض أن يكون مسرحا للتنشئة الإيجابية، يتحول هنا إلى مجال لإعادة إنتاج علاقات الهيمنة والعنف. فبينما يعيش الطفل تجربة المخيم في وضعية هشاشة، يحتل المؤطر موقعا سلطويا يتيح له – إن غابت الرقابة – أن يمارس سلطة قد تتحول إلى عنف جسدي ورمزي. وهذا ما يجعلنا أمام إعادة إنتاج لعلاقات القوة والهيمنة التي تحدث عنها بيير بورديو، حيث تكرس السلطة في غياب قواعد واضحة للمساءلة والمراقبة.
إن حادثة الاغتصاب هذه تضعنا، إذن، أمام سؤال جوهري: هل المخيمات في المغرب ما تزال مؤسسات للتنشئة والحماية، أم أنها باتت فضاءات تعكس هشاشة البنية الاجتماعية وضعف الدولة في مجال الحكامة؟ من هنا، تبدو الحاجة ملحة إلى قراءة نقدية معمقة تتجاوز التفسير الفردي للواقعة، وتعيد التفكير في السياسات العمومية للطفولة باعتبارها جزءا من مشروع المجتمع ككل.
تطرح الواقعة تساؤلات حادة حول طبيعة الظاهرة وأبعادها الاجتماعية والمؤسساتية.
فهل يمكن التعامل معها كـ سلوك شاذ ومنعزل ناتج عن انحراف فردي، أم أن الأمر يتجاوز ذلك ليعكس أزمة بنيوية مركبة تطال منظومة التخييم بما هي جزء من السياسات العمومية الخاصة بالطفولة والشباب؟
إن الإشكالية الجوهرية هنا لا تتعلق بالفعل الجرمي في حد ذاته، بقدر ما تتصل بـقدرة الدولة ومؤسساتها الوسيطة (الجامعة الوطنية للتخييم، الجمعيات الشريكة، الأطر التربوية) على ضمان فضاءات آمنة تحترم حقوق الطفل وتوفر له الحماية اللازمة. من ثم، فالمطلوب ليس فقط تفسير الواقعة، وإنما مساءلة البنية الاجتماعية والسياسية التي جعلت من وقوعها أمرا ممكنا داخل فضاء يفترض أنه تربوي وحاضن للتنشئة.
لننطلق من فرضيات أساسية:
الاعتداءات الجنسية داخل المخيمات ليست أحداثا فردية شاذة، بل هي مؤشرات على هشاشة البنية المؤسساتية، وضعف منظومة الرقابة والانتقاء والتكوين.
غياب سياسة واضحة لحماية الطفولة في فضاءات التخييم يؤدي إلى إعادة إنتاج الخطر بدل الحد منه، ما يجعل المخيمات مجالا هشا عوض أن تكون فضاءات آمنة للتنشئة الاجتماعية.
الخطاب الرسمي الذي يصوّر الوقائع كحالات استثنائية يلعب وظيفة رمزية في تبرئة البنية وتحصينها من النقد، لكنه يخفي إخفاق السياسات العمومية في حماية الأطفال وضمان شروط السلامة داخل المؤسسات التربوية.
إن الإشكالية التي تطرحها حادثة الاغتصاب في أحد المخيمات الصيفية بالمغرب لا تقتصر على تحديد ما إذا كانت الواقعة شاذة أم بنيوية، بل تنفتح على شبكة من الأسئلة الفرعية التي تعكس تعددية الأبعاد التي ينبغي مقاربتها. فعلى المستوى المؤسساتي، يبرز سؤال جوهري يتعلق بمدى قدرة آليات المراقبة والانتقاء والتكوين داخل المخيمات على ضمان حماية فعلية للأطفال، ومدى ما تكشفه هذه الواقعة عن أعطاب في الحكامة المؤسساتية. كما يفرض نفسه تساؤل آخر حول طبيعة العلاقة بين الوزارة الوصية والجامعة الوطنية للتخييم: هل هي علاقة شراكة مسؤولة قائمة على المساءلة والمحاسبة، أم أنها مجرد تفويض يرفع المسؤولية عن الدولة ويترك الجمعيات في مواجهة إكراهات تفوق إمكانياتها؟
وعلى المستوى الاجتماعي والثقافي، تطرح أسئلة مرتبطة بانعكاسات الحادثة على ثقة الأسر المغربية في المؤسسات التربوية، ومدى استعدادها لإرسال أبنائها إلى فضاءات يفترض أن تكون آمنة لكنها قد تتحول إلى فضاءات تهديد. هنا يطرح أيضا سؤال القيم: إلى أي حد يعكس الفضاء التخييمي هشاشة البنية القيمية في المجتمع، حيث يجري أحيانا التسامح الضمني مع ممارسات الإهمال والعنف الرمزي، ما يجعل الأطفال في وضعية هشاشة مضاعفة؟
أما على المستوى الخطابي والسياسي، فإن تحليل كيفية تقديم الحادثة في الإعلام الرسمي والبلاغات الوزارية يكشف بدوره عن إشكالات عميقة: كيف يعاد إنتاج خطاب “الواقعة الشاذة” بما يخدم وظيفة حماية صورة المؤسسات بدل حماية الأطفال؟ وهل يمكن القول إن مثل هذا الخطاب يمثل شكلا من أشكال العنف الرمزي الذي تحدث عنه بورديو، حيث يتم التلاعب بالمعنى لتبرئة البنية وإخفاء الإخفاقات؟ ثم، من زاوية أخرى، ألا يندرج غياب سياسة وقائية صارمة ضمن ما يسميه يوهان غالتونغ “العنف البنيوي”، حيث يصبح الحرمان من الحماية بحد ذاته شكلا من أشكال العنف المُمأسس ضد الطفولة؟
إن المقاربة المقارنة تفتح أفقا إضافيا للبحث: أين تقف التجربة المغربية في مجال حماية الأطفال في المخيمات مقارنة بتجارب دولية رائدة (مثل كندا أو فرنسا) وضعت بروتوكولات وقوانين صارمة لضمان السلامة؟ وما الدروس الممكن استخلاصها من هذه التجارب لتقوية السياسات العمومية المغربية في هذا المجال؟
بهذا المعنى، تصبح الإشكالية المركزية متعددة الأبعاد، تتوزع بين المؤسساتي والاجتماعي والثقافي والخطابي والمقارن، مما يجعل من هذه الحادثة. لفهم حادثة الاغتصاب في المخيمات الصيفية المغربية لا يكفي الاكتفاء بالوصف القانوني أو الأخلاقي، بل يتطلب الأمر الاستعانة بجملة من الأدوات النظرية التي تتيح مقاربة أعمق لبنية العلاقات والتمثلات التي تحيط بالواقعة.
في هذا السياق، يوفر إرفينغ غوفمان من خلال نظرية الوصمة إطارا تحليليا لفهم الكيفية التي يتحول فيها الاعتداء من مجرد فعل جرمي إلى مصدر لوصم جماعي. فالضحية لا ينظر إليه فقط كطفل تعرض لانتهاك، بل يحمّل ضمنيا عبء الوصم الاجتماعي، حيث يختزل في صورة “الضحية” التي قد تلازمه طوال حياته. بالموازاة مع ذلك، تمتد الوصمة إلى المؤسسات نفسها: المخيم كفضاء تربوي، والجامعة الوطنية للتخييم كفاعل مدني، وقطاع الشباب كوصي رسمي، إذ تصبح جميعها محمولة بوصمة الفشل والعجز. وهنا تكمن خطورة الواقعة كحدث يتجاوز الفرد ليطال الجماعة والمؤسسات عبر آليات التمثيل الاجتماعي.
أما بيير بورديو، فيتيح من خلال مفهوم العنف الرمزي فهم البنية الخفية التي تجعل من الاعتداء ممكنا. فالعلاقة بين المؤطر والطفل ليست متكافئة، بل هي علاقة سلطوية حيث يمتلك الراشد سلطة مادية ورمزية داخل فضاء يفترض أنه تربوي. هذا التفاوت في السلطة يفتح المجال لممارسات هيمنة قد تتحول إلى عنف مباشر (كالاغتصاب) أو عنف غير مباشر يتمثل في الصمت والتواطؤ والتطبيع مع الخطر. إن الاعتداء، في هذا المنظور، ليس مجرد انحراف فردي، بل هو إعادة إنتاج لعلاقات الهيمنة داخل فضاء اجتماعي من المفترض أن يكون محايدا وآمنا.
ومن جهته، يقدم ميشيل فوكو من خلال تحليلاته حول المراقبة والضبط مدخلا لفهم غياب الآليات الوقائية داخل فضاءات التخييم. فإذا كانت الدولة الحديثة، حسب فوكو، تمارس سلطتها عبر تقنيات الانضباط والمراقبة، فإن واقعة الاغتصاب تكشف ضعف حضور هذه التقنيات في المخيمات المغربية، سواء من حيث تكوين المؤطرين، أو من حيث الرقابة اليومية، أو من حيث غياب بروتوكولات واضحة لحماية الطفولة. إن ما يظهر هنا هو خلل في ممارسة “البيوبوليتيك” (سياسة الحياة) التي من المفترض أن تضمن حماية الأجساد الصغيرة باعتبارها جزءا من رأس المال البشري للمجتمع.وعليه، تصبح الحادثة واقعة كاشفة لا لفعل جنائي معزول، بل لبنية أوسع من الاختلالات الرمزية والمؤسساتية والسياسية التي تؤطر علاقة المجتمع والدولة بالطفولة.
تكشف حادثة الاغتصاب داخل المخيمات الصيفية المغربية عن تداخل معقد بين أبعاد مؤسساتية ورمزية واجتماعية، تجعل من الواقعة أكثر من مجرد فعل إجرامي معزول، لتصبح نافذة على أعطاب بنيوية عميقة في علاقة الدولة والمجتمع بالطفولة.
أولا: البعد المؤسساتي
إن غياب سياسة عمومية واضحة ومندمجة لحماية الأطفال داخل فضاءات التخييم، يقترن بضعف تكوين المؤطرين التربويين واعتماد معايير انتقاء هشة في الغالب، مما يحوّل المخيم إلى فضاء مفتوح على مخاطر متعددة. ويزيد من حدة الأزمة هشاشة آليات المراقبة والمساءلة؛ إذ غالبا ما تكتفي الوزارة الوصية بتفويض جزء من مسؤوليتها إلى الجامعة الوطنية للتخييم أو الجمعيات الشريكة دون وضع بروتوكولات دقيقة للرقابة، أو آليات زجرية واضحة للمحاسبة. هذا الوضع يُظهر خللًا في البنية المؤسساتية نفسها، حيث تتحول الحماية من التزام قانوني إلى مجرد خطاب شكلي.
ثانيا: البعد الرمزي
يفترض أن يشكل المخيم فضاء للأمان، التعلم، وبناء الثقة بين الطفل ومحيطه، غير أن الحادثة تكشف انقلابا في الدلالة الرمزية لهذا الفضاء: من مجال للتنشئة الاجتماعية إلى مصدر تهديد وانتهاك. هذا التحول الرمزي يعمق أزمة الثقة لدى الأسر المغربية تجاه الدولة والمؤسسات التربوية، حيث يغدو السؤال المركزي: إذا كان الطفل غير آمن داخل فضاء رسمي منظم، فأين يمكن ضمان سلامته؟ وهنا يظهر البعد الرمزي للأزمة بوصفه أخطر من الواقعة نفسها، لأنه يُنتج شكًّا طويل الأمد في العلاقة بين الأسرة والدولة.
ثالثا: البعد الاجتماعي
تعكس الواقعة أيضا أزمة أوسع في علاقة المجتمع بالمؤسسات. فبدل أن تسهم المخيمات في تقوية رأس المال الاجتماعي – بما هي فضاءات للاندماج وبناء الثقة – تتحول إلى عوامل مضعفة له، حيث تتولد شكوك في قدرة الدولة على حماية الفئات الأكثر هشاشة. هذه الشكوك تضعف الروابط الاجتماعية وتعمق الفجوة بين المواطنين والسياسات العمومية، بما يؤدي إلى إعادة إنتاج الهشاشة وعدم المساواة. فالاعتداء هنا لا يفهم فقط كجريمة فردية، بل كبنية منتجة لانعدام الثقة وتآكل رأس المال الاجتماعي الضروري لأي مشروع مجتمعي.
تثير حادثة اغتصاب طفل في إحدى المخيمات الصيفية المغربية مخاوف عميقة لدى الأسر، تتجاوز مجرد الخوف على سلامة الطفل إلى تساؤلات حول جدوى إرسال الأطفال إلى فضاءات يُفترض أن تكون آمنة. هذه المخاوف لا تتعلق فقط بالجانب الفردي، بل تمتد لتشمل ثقة الأسر في الدولة والمؤسسات التربوية، إذ يظهر القلق من أن ضعف السياسات والرقابة قد يجعل المخيمات فضاءات عرضة للاستغلال أو الانتهاك.
على صعيد آخر، قد تلعب بعض الجهات السياسية والإعلامية دورا في استثمار الواقعة لأغراض خطابية، حيث يتم تصوير الحادثة أحيانا ضمن سياق استغلال سياسي يهدف إلى توجيه النقد نحو خصوم أو لتعزيز صورة معينة للسلطة. هذا الاستخدام للواقعة يظهر كيف يمكن للأحداث الفردية أن تتحول إلى أدوات لعبة رمزية في المجال العام، ما يطرح إشكالية حول أخلاقيات الخطاب السياسي والإعلامي وأثرها على الإدراك العام للظاهرة.
من منظور سوسيولوجي نقدي، تكشف الواقعة أيضا عن أزمة في تدبير المخيمات الصيفية:
● الحاجة إلى وضع بروتوكولات صارمة لحماية الأطفال تشمل الانتقاء والتكوين والمتابعة الدورية للمؤطرين.
● تعزيز آليات المساءلة والمراقبة لضمان تطبيق المعايير بشكل مستمر.
● إعادة التفكير في سياسات التواصل مع الأسر والمجتمع لضمان الشفافية وبناء الثقة، بما يقلل من التخوفات ويحول المخيمات إلى فضاءات تعليمية وتربوية آمنة.
كما يبرز التحليل السوسيولوجي أن الأزمة ليست محصورة في حدث فردي، بل هي مؤشر على هشاشة بنيوية في العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني والأسرة، تتطلب مراجعة شاملة للمعايير التربوية والسياسات العمومية المتعلقة بالطفولة. من هذا المنطلق، يصبح العمل على حماية الأطفال ليس مجرد مسؤولية قانونية، بل التزام اجتماعي وثقافي لضمان إعادة بناء ثقة الأسر في المؤسسات التربوية وتحويل المخيمات الصيفية إلى فضاءات حقيقية للتنشئة الآمنة والإيجابية.
تظهر حادثة الاغتصاب في المخيمات الصيفية المغربية أن الواقعة ليست مجرد حدث فردي شاذ، بل هي مؤشر على هشاشة بنيوية متعددة المستويات. فالبعد المؤسساتي يكشف ضعف السياسات العمومية وآليات الرقابة والمساءلة، مما يجعل فضاءات التخييم غير محمية كما يفترض. والبعد الرمزي يبرز تحول الفضاء التربوي من مصدر للطمأنينة إلى مجال للتهديد، ما يخلخل الثقة بين الأسرة والدولة وينتج وصما اجتماعيا طويل الأمد. أما البعد الاجتماعي، فيؤكد أن هذه الوقائع تُضعف رأس المال الاجتماعي وتعمّق الشكوك في قدرة المؤسسات على حماية الفئات الهشة، ما ينعكس على العلاقة بين المجتمع والدولة.
من منظور سوسيولوجي نقدي، فإن الحادثة تدعو إلى إعادة بناء منظومة حماية الطفل في المغرب على أسس شاملة:
• تطوير سياسات واضحة للصلاحية والرقابة داخل المخيمات، مع بروتوكولات صارمة للمساءلة.
• تكوين المؤطرين تربويا ونفسيا لضمان وعي كامل بمخاطر الانتهاكات.
• تعزيز المشاركة المجتمعية وشفافية المؤسسات، بما يخلق فضاءات ثقة ويعيد بناء رأس المال الاجتماعي.
وبذلك، تصبح الحادثة فرصة لإعادة التفكير في العلاقة بين الدولة، المجتمع المدني، والأسرة، لضمان أن تكون المخيمات الصيفية فضاءات آمنة للتنشئة الاجتماعية والتربية، لا تهديدا للطفولة، بل فرصة لإعادة تأكيد قيم الحماية والكرامة والمواطنة.