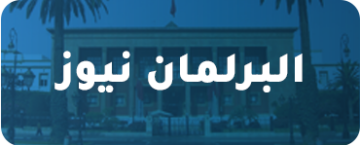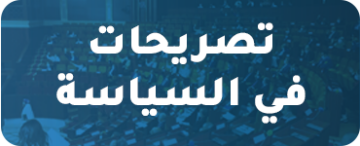مهرجان القنيطرة: نقاش هادئ بعد انتهاء النسخة الأولى
وفي المقابل، واجه المهرجان موجة من الانتقادات التي لا يمكن تجاهلها، خصوصا فيما يتعلق بالبرمجة الفنية. فقد أحدث حضور فنان الراب “طوطو” زوبعة كبيرة، نظرا لقدرته على حشد جمهور غفير، لكنه أثار جدلا أوسع حول تأثيره على الذوق العام، خاصة لدى الناشئة، حين يصعد إلى المنصة وفي يده أو فمه لفافة حشيش.
■ إلياس أعراب| فاعل مدني
القنيطرة | أسدل الستار يوم الثلاثاء 26 غشت 2025 على النسخة الأولى من مهرجان القنيطرة، الذي أقيم تحت شعار “القنيطرة: دابا تزيان”. هذه النسخة خلفت نقاشا واسعاً داخل أوساط المتتبعين للشأن الثقافي والفني بالمدينة وخارجها، سواء قبل، أثناء، أو بعد المهرجان، بدءاً من الميزانية المرصودة له وصولاً إلى الاختيارات الفنية والحضور الجماهيري. فهناك من رأى في هذه المبادرة خطوة جريئة لإعادة الاعتبار للقنيطرة وفتحها على مشهد فني طال انتظاره، بينما اعتبرها آخرون مجرد نسخة تجريبية لم تحقق ما كان مرجواً منها. وكما هي عادة البدايات، فإن التجارب الأولى لا تقاس بمعايير النجاح المطلق أو الفشل الذريع، بل هي فرصة لاستخلاص الدروس وبناء رؤية أوضح للدورات القادمة. وفي نقاشنا هذا سنحاول الوقوف على عدة نقاط أثارها المتتبعون وأخرى رصدناها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقبل الخوض في نقاش السلبيات والإيجابيات، لا بد من التوقف عند الشعار الذي اختاره المنظمون لهذه النسخة: “القنيطرة روح غرباوة”.
الشعار يعكس هوية المدينة وروح سكانها المتفردة، ويجمع بين الانتماء المحلي والفخر بالهوية الغرباوية، كما يبرز الخصوصية الثقافية للمدينة وسط المدن المغربية الأخرى باعتبارها عاصمة الغرب وحاضرتها. في الوقت نفسه، يحمل الشعار رسالة تواصلية قوية مفادها أن القنيطرة ليست مجرد فضاء جغرافي، بل هي روح وثقافة ونبض جماعي يميز سكانها. وقد تعزز هذا الفخر بالانتماء من خلال برمجة سمفونية الهايت الغرباوي في افتتاح المهرجان، وإقامة ندوة فكرية حول الموضوع، إلى جانب مجموعة من الأنشطة المصاحبة.
إلى جانب ذلك، أطلق المنظمون شعارا آخر في إطار حملتهم الترويجية، وهو “دابا تزيان” وبقدر ما يبدو بسيطا وعفويا، فإنه يحمل شحنة رمزية قوية تعكس الأمل والتفاؤل بغد أفضل، وتدل على رغبة جماعية في تجاوز سنوات الانتظار والتأجيل التي طبعت صورة المدينة. فمن جهة، هو رسالة إيجابية مفادها أن القنيطرة بدأت تستعيد مكانتها ثقافيا وقطارها اتسق فوق سكته، خاصة مع إنشاء المنصة الكبرى في محطة القطار، مما يعكس انسجاماً رمزيّاً بين الفكرة والمكان. ومن جهة أخرى، قد ينظر إلى الشعار على أنه وعد أكبر من حجم النسخة الأولى، لأن التحدي الحقيقي يكمن في ترسيخ مشروع ثقافي متين يجعل “دابا تزيان” واقعا ملموسا وليس مجرد عبارة مرحلية. و”الزين لي فقنيطرة” لا بد أن يبدأ في الظهور مباشرة بعد انتهاء هذه النسخة من خلال الانكباب على الملفات التي تؤرق بال الساكنة، مثل مشكل الإنارة العمومية، والنظافة، والاختناق المروري، والحفر التي حولت بعض شوارع المدينة إلى فخاخ للسائقين.
قد نختلف اذن على طريقة تنزيل المهرجان على أرض الواقع والسرعة التي اتسمت بها والغموض الذي لف الجمعية المنظمة، لكن لا يمكن إنكار أن هذه النسخة كسرت حالة الجمود التي طبعت المشهد الثقافي المحلي لسنوات. فقد استطاع المهرجان جمع جمهور واسع من فئات عمرية مختلفة، ومنحهم فرصة عيش لحظات احتفالية مع فنانيهم المفضلين. كما أتاح فرصة لعدد من الفنانين المحليين للصعود إلى المنصة الرسمية وملاقاة جمهور مدينتهم، ما يعزز مكانة الإبداع المحلي ويشجع على استمراريته. كما شملت البرمجة أنشطة رياضية متنوعة (التبوريدة، كرة السلة، الكرة الحديدية …)، وأنشطة للأطفال، وندوة فكرية، مما زاد من تنوع البرنامج رغم أن التركيز العام كان على السهرات. أما اقتصاديا، فقد ساهم المهرجان ولو بشكل محدود في تنشيط الدورة التجارية بالمدينة، إذ استفادت الفنادق والمطاعم والمقاهي وحتى النقل من توافد الزوار من مدن مجاورة. هذا البعد الاقتصادي مهم لأنه يبرز أن الاستثمار في الثقافة ليس إنفاقا عبثيا، بل يمكن أن يكون محركا للتنمية المحلية.
وفي المقابل، واجه المهرجان موجة من الانتقادات التي لا يمكن تجاهلها، خصوصا فيما يتعلق بالبرمجة الفنية. فقد أحدث حضور فنان الراب “طوطو” زوبعة كبيرة، نظرا لقدرته على حشد جمهور غفير، لكنه أثار جدلا أوسع حول تأثيره على الذوق العام، خاصة لدى الناشئة، حين يصعد إلى المنصة وفي يده أو فمه لفافة حشيش.
وهنا يبرز سؤال مهم: هل يفرض طوطو شروطه قبل قبول دعوة أي مهرجان، أم أن اللجنة المنظمة توافق على هذه الممارسات بدافع جذب أكبر عدد من الحاضرين؟ بعبارة أخرى، هل المسؤولية تقع على الفنان وحده، أم على المنظمين الذين لم يجدوا حلا يمنع صعوده إلى المنصة بهذا الشكل؟ هذا التساؤل يعكس ضرورة وضوح سياسات البرمجة والمعايير الأخلاقية والفنية التي يجب أن تحكم أي مهرجان يسعى لأن يكون حدثا حضارياً متكاملا. فالنقاش هنا لا يتعلق بحرية الفنان في ممارسة عاداته الشخصية، بل بالمسؤولية تجاه الجمهور، خصوصا القاصرين، وواقعية الحدث في دولة لم تصدر بعد قانون الاستعمال الترفيهي للحشيش. لذا، فإن تنظيم أي مهرجان يتطلب توازنا بين احترام حرية الفنان وواجب الحفاظ على الصورة العامة والذوق الفني للجمهور واحترام القانون.
من جهة أخرى، أثارت الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها اللجنة المنظمة بخصوص الحضور الجماهيري، والتي قدمت كدليل على نجاح النسخة الأولى، وخاصة في سهرات الأسماء الأكثر جماهيرية مثل طوطو وسعد المجرد، الكثير من الاستغراب والاستنكار. فقد اعتبرها البعض أرقاما مبالغا فيها ولا تعكس الواقع الميداني، متهمين المنظمين بتضخيمها لأغراض دعائية وإعلامية.
ورغم أنه لا خلاف حول الإقبال الكبير الذي شهدته السهرات الفنية، إلا أن غياب آليات دقيقة لاحتساب الأعداد جعل هذه المعطيات محل تشكيك واسع. ومع ذلك، يبقى من الإنصاف الاعتراف بأن المهرجان حقق حضورا جماهيريا قياسيا، حتى وإن ظل النقاش قائما حول دقة الأرقام المعلنة.
هذا الحضور الجماهيري الكثيف كشف أيضا عن جانب آخر من النقاش، حيث برزت مواقف تنم عن نزعة عنصرية مستترة لدى بعض المنتقدين، الذين سعوا إلى تبرير الإقبال الكبير على المهرجان بأنه صادرا عن “البراني” وليس عن أبناء المدينة. وكلما انتشرت صورة أو مقطع غير مشرف لسلوك فردي أو جماعي من إحدى السهرات، تعالت تعليقات من قبيل: “ماشي ولد قنيطرة” أو “هركاوة عمروا قنيطرة”.
مثل هذه المواقف لا تعكس فقط عجزا عن خوض نقاش فكري جاد حول المهرجان وجدواه، بل تكشف أيضا ضيق أفق في زمن أصبح فيه العالم قرية صغيرة، تتداخل فيه الهويات والفضاءات. فبدل الاكتفاء بإلقاء اللوم على “الآخر” وتبرئة الذات، الأجدر هو الانخراط في نقاش مسؤول حول دور المهرجان في تربية الذوق الفني وتدبير الفضاء العام وإيجاد توازن بين الحرية الفردية واحترام القيم الجماعية.
ومن النقاط التي لا تخلو أهمية وأثارها عدد من المتتبعين مسألة إشراك الفنان المحلي. صحيح أن بعض السهرات عرفت مشاركة أسماء معروفة في المدينة كالفنان فريد القنيطري والشاب جمال، إلا أن أسماء أخرى من العازفين والمبدعين المحليين غابت عن البرمجة. وهنا لا بد من الإقرار بواقعية المعطيات: فمثلا، عازف ناي أو فنان فردي مهما كانت موهبته، قد لا يستطيع استقطاب جمهور واسع على منصة كبرى، لكن كان بالإمكان إيجاد صيغ بديلة لرد الاعتبار لهؤلاء الفنانين، مثل تخصيص لحظات تكريم قصيرة بين الفقرات، أو برمجة حفلات موازية في فضاءات أصغر وأكثر حميمية، كالمركب الثقافي الذي ظل غائباً عن المشهد طيلة المهرجان.
كما سجل غياب شبه تام لمجالات إبداعية أخرى مثل المسرح والفن التشكيلي، وهو ما يمثل فرصة ضائعة لإبراز التنوع الثقافي بالمدينة. وقد يكون من الضروري أن تعمل جمعية المهرجان مستقبلا على الانفتاح أكثر على الفاعلين المحليين، من جمعيات ثقافية وفنية وهيئات المجتمع المدني، لأن هؤلاء الأقدر على فهم نبض الساكنة وتقديم مقترحات عملية لتجويد البرمجة والتنظيم. كما أن إشراك المؤسسات التعليمية والجامعية قد يفتح الباب أمام الطلبة والشباب للمساهمة في التأطير والتنشيط، مما يمنح المهرجان بعدا تربويا وتنمويا يتجاوز مجرد الفرجة الفنية إلى مشروع ثقافي متكامل.
وبالحديث عن المشروع الثقافي المتكامل، لا بد من التوقف عند الندوة الفكرية الوحيدة التي نظمت على هامش المهرجان، والتي تناولت موضوع الهايت الغرباوي: تراث ثقافي لا مادي. ورغم أهمية الموضوع وما يحمله من رمزية تاريخية وفنية، فقد عرفت الندوة حضورا ضعيفا ومتابعة إعلامية محدودة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام.
فالكثير من الأصوات التي لا تكف عن التنظير على شبكات التواصل الاجتماعي كانت غائبة تماما عن هذا الموعد، وكأن النقاش الفكري لا يعنيها إلا من وراء الشاشات. فهل السبب يكمن في طبيعة الموضوع المثار أم في منطق “نلعب ولا نحرمها”؟ المؤكد أن المشاركة في النقاش الفكري لا تحتاج إلى دعوة رسمية، بل إلى وعي بأهمية الفكر في ترسيخ هوية المهرجان وتطويره ليكون أكثر من مجرد حفلات موسيقية.
ومن هنا، لا بد من طرح السؤال الأهم على إدارة المهرجان: ما هي الرؤية المستقبلية للمهرجان على المدى المتوسط والبعيد؟ وما هي هويته الحقيقية؟ هل هو مهرجان موسيقي شبابي بالأساس، أم يسعى لأن يكون ملتقى ثقافيا شاملا يضم المسرح والسينما والفنون التشكيلية والرياضات الجماعية والفردية؟ وضوح الهوية سيتيح بناء جمهور وفيّ، ويجنب الدخول في نقاشات مستقبلية لا طائل منها، كما يضمن عدم الانزلاق في محاولة تقليد مهرجانات أخرى أكبر وأقدم.
فالرهان الأكبر اليوم ليس الحكم على نجاح أو فشل النسخة الأولى، بل ضمان استمرارية المهرجان. فكثير من المدن المغربية شهدت إطلاق مهرجانات سرعان ما توقفت بعد دورة أو دورتين بسبب غياب الدعم أو ضعف التخطيط والرؤية.
ما تحتاجه القنيطرة هو تحويل مهرجانها إلى موعد سنوي ثابت، له هوية خاصة وسمعة تراكمية تجعله محطة منتظرة من الجمهور والفنانين على السواء. ولن يتحقق ذلك إلا إذا توفرت إرادة جماعية حقيقية، تقوم على الشفافية في التدبير، وضوح الأهداف، والانفتاح على جميع الملاحظات النقدية بروح بنّاءة.
وكخلاصة تقييمية، يمكن القول إن مهرجان القنيطرة في نسخته الأولى تجربة تستحق التشجيع، لأنها كسرت الجمود الثقافي وخلقت لحظات فرح جماعي يحتاجها المواطنون. لكنه في الوقت نفسه يظل مشروعا في طور التشكل، يحتاج إلى كثير من المراجعة والتجويد. فلا ينبغي النظر إليه كنجاح باهر ولا كفشل ذريع، بل كتجربة أولى يمكن البناء عليها إذا توفرت الميزانية الكافية، الاحترافية في التنظيم، والطموح الثقافي الصادق الذي يضع مصلحة المدينة وساكنتها في قلب المشروع.