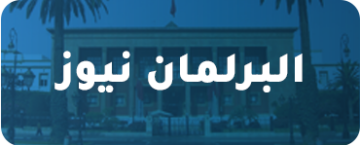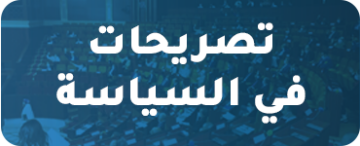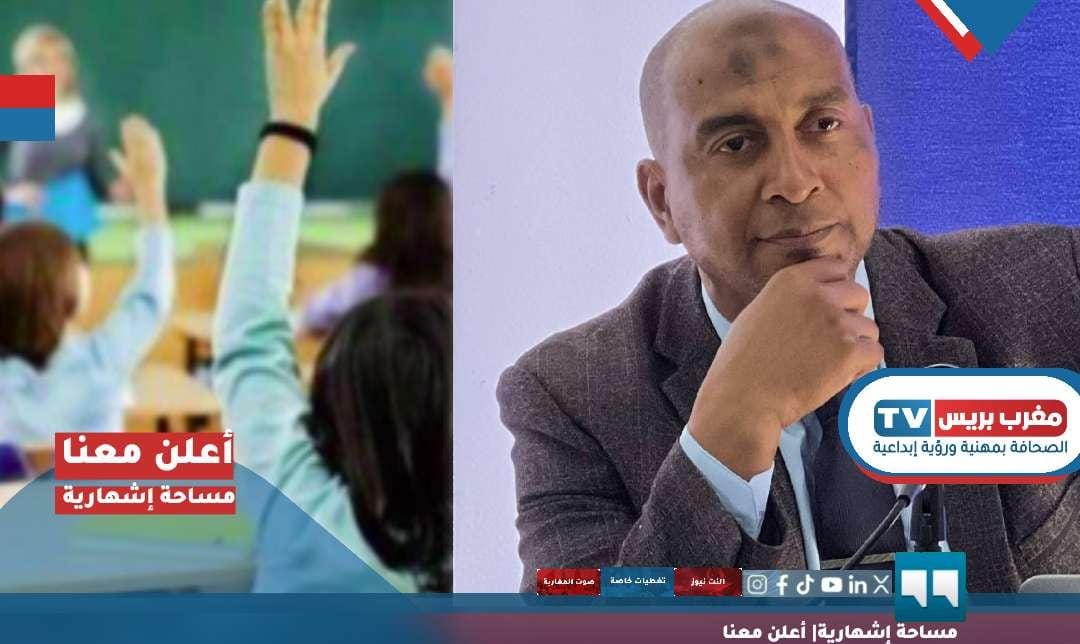روائز الإقصاء:السلطة الصامتة في التعليم الخصوصي المغربي..وزارة لا تحرك ساكنا أمام وضع خطير
إن هذه الممارسة ترتبط ارتباطا وثيقا بما يسميه بيير بورديو بـ”إعادة إنتاج اللامساواة”، إذ يتم انتقاء المتعلمين الذين يتوفرون سلفا على رأسمال ثقافي قوي بفضل خلفياتهم الاجتماعية والأسرية، في حين يتم استبعاد أو تهميش من يفتقرون إلى ذلك الرأسمال.
■د.هشام بوقشوش| باحث في علم الإجتماع
الرباط|يشكل التعليم الخصوصي في المغرب مجالا سوسيولوجيا كاشفا لآثار التحولات النيوليبرالية التي مست الحقل التربوي. فالمؤسسة التعليمية الخصوصية لم تعد مجرد فضاء للتنشئة الاجتماعية أو لنقل المعارف، بل تحولت إلى فاعل اقتصادي يتعامل مع التلميذ باعتباره رأسمالا بشريا قابلا للاستثمار والتسويق. هذا التحول يعكس انتقال المدرسة من منطق الخدمة العمومية إلى منطق المقاولة، حيث تقاس القيمة التعليمية بمدى القدرة على إنتاج مؤشرات النجاح والتفوق القابلة للتداول في سوق تنافسي.
في هذا الإطار تبرز روائز التقويم التشخيصي الآلي كآلية مركزية لإدارة هذا المنطق الجديد. فهي لا تستخدم باعتبارها أداة بيداغوجية غايتها تشخيص مواطن القوة والضعف عند المتعلمين قصد توجيه الدعم التربوي، بل تتحول إلى أداة للانتقاء والفرز. إذ يعاد من خلالها تحديد من يحق له الولوج إلى فضاء “التفوق المدرسي” ومن يقصى بدعوى ضعف القدرات أو وجود صعوبات تعلمية. وبذلك تختزل العملية التربوية في ممارسة إقصائية تقصي الاختلاف وتقصي بالأساس الفئات الهشة والأطفال الذين هم في أمس الحاجة إلى مواكبة تربوية دامجة.
إن هذه الممارسات لا تنفصل عما يسميه بيير بورديو بـ”إعادة إنتاج اللامساواة الاجتماعية”، حيث تستفيد الفئات الميسورة ذات الرأسمال الثقافي المسبق من شروط مواتية للنجاح، بينما يعاد تهميش الفئات الأقل حظا. كما يمكن فهم هذه الآليات من منظور إرفينغ غوفمان في إطار “الوصم”، حيث يصنف الطفل ذو الصعوبات التعليمية كـ “آخر ناقص” داخل المؤسسة، ويدفع تدريجيا إلى الهامش المدرسي والاجتماعي.
وبموازاة ذلك، يكشف صمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أمام هذه الممارسات عن نوع من التواطؤ البنيوي، إذ تخلت الدولة عن دورها كضامن لتكافؤ الفرص، وتركت منطق السوق يهيمن على الفعل التربوي. هذا الصمت لا يعكس فقط ضعف الرقابة، بل يترجم أيضاً حضور “سلطة صامتة” بالمعنى الفوكوي، حيث تعمل آليات الإقصاء والتمييز في غياب صريح لأي قرار رسمي، لكنها تكتسب شرعيتها من خلال غياب التدخل والمساءلة.
إن خطورة هذه الظاهرة تكمن في أنها تحوّل المدرسة من فضاء يفترض أن يكون مجالا لإنتاج العدالة الاجتماعية والاندماج، إلى سوق مغلق يسوّق “التفوق” كسلعة ويمارس الفرز والانتقاء على حساب مبدأ الحق في التعلم.
وهكذا، فإن روائز التقويم التشخيصي الآلي ليست مجرد تقنية تعليمية، بل هي تعبير عن بنية اجتماعية أوسع تشرعن اللامساواة وتعيد إنتاجها جيلا بعد جيل.
■المدرسة كسوق للتفوق الأكاديمي
من خلال اعتماد هذه الروائز، لا تسعى المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى دعم تعلمات المتعلمين بقدر ما تروم انتقاء قاعدة من التلاميذ ذوي الأداء العالي مسبقا. فالهدف الأساسي هو ضمان نسب مرتفعة من النجاح والتميز المدرسي، بما يعزز صورتها المؤسسية ويمنحها رأسمالا رمزيا تسويقياً في سوق التعليم. بهذا المعنى، يغدو التقويم التشخيصي الآلي آلية لإنتاج “التفوق المعلب” أكثر منه وسيلة لإنصاف المتعلمين ومواكبة حاجاتهم.
إن هذه الممارسة ترتبط ارتباطا وثيقا بما يسميه بيير بورديو بـ”إعادة إنتاج اللامساواة”، إذ يتم انتقاء المتعلمين الذين يتوفرون سلفا على رأسمال ثقافي قوي بفضل خلفياتهم الاجتماعية والأسرية، في حين يتم استبعاد أو تهميش من يفتقرون إلى ذلك الرأسمال. وبذلك ترسخ المدرسة الخصوصية منطق “الانتقاء الاجتماعي”، حيث يصبح النجاح المدرسي انعكاسا مباشرا للامتيازات الطبقية والثقافية، لا ثمرة لمسار بيداغوجي عادل وشامل.
■الإقصاء الممنهج وآليات الوصم
يقابل هذا الانتقاء إقصاء صامت للتلاميذ الذين يعانون صعوبات في التعلم أو يمتلكون قدرات معرفية بسيطة، حيث لا يُنظر إليهم باعتبارهم أطفالا لهم حق أصيل في الدعم والمواكبة التربوية، بل يتم التعامل معهم كـ”عائق محتمل” قد يهدد صورة المؤسسة وسمعتها في سوق التعليم الخصوصي. بهذا المعنى، يتحول الطفل من ذات لها قابلية للنمو والتعلم إلى مجرد مؤشر سلبي يسهم في خفض معدلات النجاح والتفوق المؤسسي.
وفق مقاربة إرفينغ غوفمان حول الوصم الاجتماعي، فإن هؤلاء التلاميذ يُزجّ بهم في دائرة “الاختلاف السلبي”، حيث يعاد إنتاج صورتهم داخل الحقل التربوي كـ”غير أكفاء”، أو “خارجين عن المألوف”، بما يفضي إلى تهميشهم الرمزي والفعلي معا. إن هذا الوصم لا يقتصر على التجربة المدرسية الراهنة، بل يمتد ليهدد اندماجهم المستقبلي في الفضاء الاجتماعي الأوسع، إذ يترسخ لديهم شعور بالدونية والإقصاء، وتتكرس لديهم هوية “موسومة” بالهشاشة والقصور.
بهذا الشكل، يغدو الإقصاء التربوي في المؤسسات الخصوصية آلية مضاعِفة للحرمان الاجتماعي، حيث يترجم منطق السوق إلى عنف رمزي (بالمعنى البوردوي) يعيد إنتاج الهشاشة ويغذي آليات التفاوت الطبقي والمعرفي جيلا بعد جيل.
■صمت الوزارة وتواطؤ السياسات
إن صمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أمام هذه الممارسات لا يمكن فهمه إلا باعتباره تواطؤا ضمنيا مع منطق السوق الذي يهيمن على الحقل التعليمي. فالدولة، التي يفترض أن تضطلع بدور الضامن لمبدأ تكافؤ الفرص وحامية للحق الدستوري في التعليم، تترك المجال مفتوحاً أمام المؤسسات الخصوصية لتُمارس منطق الانتقاء والتمييز من دون رقيب أو مساءلة. وبذلك يتحول مبدأ المساواة الدستورية إلى مجرد شعار فارغ يرفع في الخطابات الرسمية، بينما يُفرغ من مضمونه في الممارسة اليومية.
هذا الصمت لا يمثل مجرد حياد سلبي، بل يجسد ما أشار إليه ميشيل فوكو في تحليلاته حول أشكال السلطة الصامتة التي تشتغل من خلال آليات غير مباشرة، حيث يغدو الامتناع عن التدخل نفسه شكلاً من أشكال الهيمنة. فالوزارة، عبر غيابها، تشرعن ممارسات الإقصاء وتضفي عليها طابع “الطبيعي”، مما يرسخ اللامساواة كأفق بنيوي للتعليم الخصوصي. وهكذا، يصبح الصمت السياسي والإداري أداة خفية لإعادة إنتاج اللامساواة، عبر نقل سلطة القرار التربوي إلى منطق السوق، وإضعاف المدرسة كفضاء للعدالة الاجتماعية.
■النتائج الاجتماعية
إعادة إنتاج اللامساواة: إن اعتماد الروائز التشخيصية كآلية للانتقاء يعزز موقع الفئات الميسورة التي تمتلك رأسمالا ثقافيا ومعرفيا مسبقا، في حين يُقصى الأطفال القادمون من أوساط اجتماعية هشة أو محرومة. وهكذا تتحول المدرسة، التي يفترض أن تكون أداة للترقي الاجتماعي، إلى قناة لإعادة إنتاج الفوارق الطبقية عبر الأجيال.
●تهميش التنوع التربوي: يفترض في التقويم أن يكون وسيلة لتشخيص الفروق الفردية بين المتعلمين قصد توفير الدعم البيداغوجي الملائم. غير أن الممارسة القائمة تحوله إلى أداة لإقصاء الاختلاف، ما يؤدي إلى طمس التنوع التربوي وتكريس صورة نمطية واحدة للنجاح، تقوم على الأداء الأكاديمي الصرف دون اعتبار للاختلافات في القدرات والاحتياجات التعليمية.
●تحويل المدرسة إلى سوق: تغدو المدرسة الخصوصية فضاءً اقتصادياً لتسويق “النجاح المعلب مسبقاً”، بدل أن تكون فضاءً للاندماج الاجتماعي والتنشئة على قيم المواطنة. فالمؤسسة لا تقيس قيمتها بمدى قدرتها على احتضان مختلف المتعلمين، بل بمدى قدرتها على إنتاج مؤشرات قابلة للتسويق، ما يجعل التعليم سلعة ويفرغ وظيفته التربوية والاجتماعية من مضمونها.
■انخراط المؤسسات التعليمية والآباء في الإقصاء التربوي
يشكل اعتماد المؤسسات التعليمية الخصوصية للروائز التشخيصية الآلية آلية مزدوجة للإقصاء، فهي ليست مجرد أداة تقييم، بل آلية فرز اجتماعي تحدد من يحق له الولوج إلى فضاء التفوق المدرسي ومن يقصى. اللافت أن هذه الممارسة تتلقى شرعنة ضمنية داخل المؤسسة نفسها، حيث ينظر إليها على أنها مقبولة تربوياً وضرورية لضمان جودة التعليم وسمعة المؤسسة في سوق تنافسي.
من منظور سوسيولوجي نقدي، يظهر هذا الانخراط المؤسساتي كيف تتحول المدرسة من فضاء تربوي يهدف إلى تنمية جميع المتعلمين إلى مؤسسة تنتج وتكرس الامتيازات. إذ إن الروائز لا تقيس القدرات الفعلية للتلاميذ في ضوء اختلافاتهم، بل تفرزهم وفق ما يسميه بورديو الرأسمال الثقافي المسبق، بما يعزز مكانة أبناء الفئات الميسورة ويهمش الأطفال من خلفيات هشة، مع ما يترتب على ذلك من إعادة إنتاج للامساواة الاجتماعية.
في المقابل، يبرز انخراط الآباء في هذه العملية كعنصر مركزي في دينامية الإقصاء. فعدد كبير من الأسر، بدوافع حماية مصالح أبنائهم وضمان تفوقهم، يشارك طواعية في آليات الفرز، عبر تشجيع اختبارات القبول والمقاييس الصارمة. هذا الانخراط، رغم أنه يبدو فردياً أو مدفوعاً بمصالح شخصية، في الواقع يساهم في شرعنة منطق السوق داخل المدرسة ويمنح الممارسة هالة من القبول الاجتماعي، ما يجعلها تبدو طبيعية و”تربوية” في أعين الجميع، بما في ذلك الفئات المستهدفة من الإقصاء.
يمكن تفسير هذا التواطؤ الاجتماعي الجزئي من منظور إرفينغ غوفمان و”الوصم الرمزي”، حيث ينشأ لدى الأطفال ذوي الصعوبات شعور بالدونية والإقصاء، بينما يغدو النجاح معيارا متاحا فقط لمن يمتلك الموارد الثقافية والاجتماعية اللازمة. من زاوية أخرى، يرى ميشيل فوكو أن هذه الشرعنة الاجتماعية تعكس السلطة الصامتة التي تعمل عبر آليات غير مباشرة: المدرسة والآباء يساهمون، دون وعي كامل، في إنتاج الهيمنة الرمزية التي تُكرّس الفوارق الاجتماعية والتمييز على أساس القدرات المفترضة.
إن قراءة سوسيولوجية نقدية لهذه الظاهرة تكشف أن المشكلة ليست في الروائز نفسها، بل في النظام الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي يجعل من الإقصاء ممارسة مقبولة ومشرّعة، حيث تتحول المدرسة إلى فضاء لإعادة إنتاج الامتيازات وإقصاء الفئات الهشة، ويصبح حق الطفل في التعلم أداة قابلة للتفاوض والتسليع. هذه الرؤية تظهر أن الإصلاح التربوي لا يمكن أن يقتصر على تعديل أدوات التقويم، بل يجب أن يشمل تغيير العقلية المؤسساتية والاجتماعية، وضمان التزام الجميع، مؤسسات وآباء، بمبدأ العدالة التعليمية وحق جميع الأطفال في التعلم المتكافئ.
■نحو بديل تربوي عادل
إن أي مقاربة بديلة لمعالجة هذه الإشكالية لا يمكن أن تنفصل عن مطلب العدالة الاجتماعية باعتباره شرطا مركزيا لإصلاح المنظومة التربوية. فالتقويم التشخيصي، بدل أن يستعمل كأداة للفرز والإقصاء، ينبغي أن يُعاد تعريفه كآلية بيداغوجية هدفها تشخيص الحاجات التعليمية الفعلية للمتعلمين وتكييف التدخلات التربوية بما يستجيب لتنوع قدراتهم وخلفياتهم الاجتماعية. إن جوهر العملية التربوية لا يكمن في إنتاج نسب نجاح مرتفعة، بل في ضمان الحق في التعلم للجميع وفق مبادئ الإنصاف والدمج.
ومن هذا المنظور، فإن مسؤولية وزارة التربية الوطنية لا تتجسد فقط في وضع مناهج ومعايير، بل في إرساء آليات صارمة للمراقبة والتتبع تضمن التزام المؤسسات التعليمية، خصوصية وعمومية، بحق جميع الأطفال في تعليم منصف. ويشمل ذلك توفير دعم بيداغوجي ملائم للتلاميذ ذوي الصعوبات، عوض تركهم ضحايا الإقصاء أو الوصم. إن الاعتراف بالتنوع داخل القسم الدراسي ليس ضعفا بل قوة تربوية، لأنه يفتح أفقاً لبناء مدرسة دامجة قادرة على احتضان الاختلاف كشرط أساسي لتكافؤ الفرص ولتعزيز العدالة التربوية والاجتماعية.
تكشف التجربة المغربية في اعتماد المؤسسات التعليمية الخصوصية لروائز التقويم التشخيصي الآلي عن انزلاق بنيوي خطير، من مدرسة يفترض أن تضطلع بوظيفة إنتاج العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، إلى مؤسسة اقتصادية محكومة بمنطق السوق تعيد إنتاج الفوارق الطبقية وتُقصي الفئات الأكثر هشاشة. فبدل أن يكون الفضاء المدرسي مجالا لاحتضان التعدد الاجتماعي والتربوي، يتحول إلى آلية لتكريس الامتيازات وإعادة إنتاجها عبر آليات انتقائية مغلفة بخطاب تربوي.
إن هذه الممارسات لا يمكن اختزالها في كونها مجرد “اختلال بيداغوجي” أو “انحراف تدبيري”، بل هي في جوهرها جريمة اجتماعية صامتة ترتكب في حق الطفولة المغربية، لأنها تحرم جزءا واسعا من المتعلمين من حقهم الدستوري في تعليم منصف ودامج. والأخطر أنها تمارس تحت غطاء الشرعية المؤسسية وبتواطؤ ضمني من الدولة، ما يعكس الكيفية التي يمكن أن تحوّل بها السياسات النيوليبرالية المدرسة من فضاء للتحرر إلى أداة لإعادة إنتاج الهيمنة الاجتماعية.
وبذلك يغدو الحق في التعلم، الذي يفترض أن يكون حقا كونيا، مجرد امتياز طبقي متاح لمن يمتلك الرأسمال الاقتصادي والثقافي المؤهل للولوج إلى سوق التعليم الخصوصي، في حين يدفع باقي الأطفال إلى هامش الحرمان والإقصاء.
■نحو بدائل عادلة
إن تجاوز هذه الاختلالات يقتضي إعادة التفكير في موقع المدرسة داخل المجتمع المغربي بعيدا عن منطق السوق وضغوط الربح. وفي هذا السياق يمكن اقتراح مجموعة من البدائل:
●إعادة تعريف وظيفة التقويم التشخيصي: ينبغي أن يُعتمد كأداة بيداغوجية لتشخيص الحاجات التعليمية الحقيقية للتلاميذ، وتكييف الممارسات التربوية وفق اختلافاتهم، لا كآلية انتقائية.
●إرساء سياسات إدماج فعالة: من خلال توفير دعم بيداغوجي خاص للتلاميذ ذوي الصعوبات، وتمكينهم من أدوات تعويضية وبرامج مساندة، بما يضمن حقهم في التعلم على قدم المساواة.
●تعزيز الرقابة والمحاسبة: تقع على عاتق وزارة التربية الوطنية مسؤولية وضع آليات صارمة للمراقبة والتتبع، لضمان احترام المؤسسات التعليمية، خصوصية وعمومية، لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستورياً.
●تمكين المدرسة العمومية: باعتبارها الضامن الأساسي للعدالة الاجتماعية، يجب أن تدعم ماديا وبيداغوجيا لتستعيد دورها كفضاء للإنصاف والدمج، بدل ترك الأسر رهينة لابتزاز السوق التعليمي.
●تربية على التنوع: يجب أن تتحول المدرسة إلى فضاء للتنشئة على قبول الاختلاف والتنوع في القدرات، وأن ينظر إلى الفروق الفردية كقيمة مضافة، لا كعائق أمام النجاح.