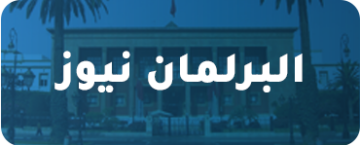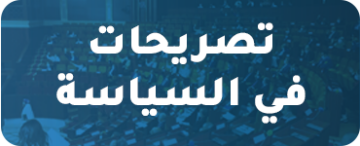العقوبات البديلة في المغرب:بين الخطاب الإصلاحي وإكراهات الواقع السجني
البيان التوضيحي ليس مجرد وثيقة إدارية عابرة، بل هو نص كاشف عن عمق التناقضات التي تحكم السياسات العقابية بالمغرب: بين الضغط التدبيري الذي تعانيه السجون، وبين الطموح الإصلاحي الذي يسعى إلى تقليص الاكتظاظ عبر إدماج العقوبات البديلة. وهو ما يستدعي مقاربة سوسيولوجية تنصت لهذه التناقضات وتفككها في ضوء نظريات العقوبة والسلطة والانضباط الاجتماعي.
■ د. هشام بوقشوش | باحث في علم الاجتماع
الرباط| يشكل البيان التوضيحي الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشأن تنفيذ مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة مدخلا دالا لفهم التحولات الراهنة التي تعرفها السياسة الجنائية بالمغرب، وما يرافقها من رهانات وإكراهات. فالخطاب الرسمي الذي يركز على الجوانب التقنية والإجرائية ـ من قبيل جاهزية المنصات الإلكترونية، وتكوين الموظفين، وتوفير الأساور الإلكترونية ـ يقدم صورة ظاهرها الطمأنة حول جاهزية المؤسسة السجنية لتنزيل الإصلاح، غير أن القراءة السوسيولوجية تكشف أن القضية أعقد من مجرد مسألة لوجستية أو تنظيمية.
إذ يتعلق الأمر بتحول جذري في فلسفة العقوبة، وما يستتبع ذلك من أسئلة عميقة حول علاقة المجتمع بالجريمة، ومدى قدرة مؤسساته على التكيف مع منطق “الإدماج” بدل “الردع”. فمن منظور سوسيولوجي، لا يمكن فهم إشكالية العقوبات البديلة خارج البنية الثقافية والاجتماعية التي تحدد معنى العقوبة والعدالة داخل المخيال الجماعي.
وهنا تبرز التوترات بين ثقافة اجتماعية تميل إلى اعتبار السجن العقوبة “الطبيعية” والشرعية، وبين إرادة سياسية وقانونية تسعى إلى إدماج بدائل غير سالبة للحرية، في أفق تحقيق عدالة أكثر مرونة وفعالية.
إضافة إلى ذلك، فإن تنزيل هذه المقتضيات يضعنا أمام إشكالات مؤسساتية وتدبيرية تتعلق بمدى جاهزية الدولة والمجتمع على السواء لتحمل المسؤولية المشتركة في تنفيذ هذه العقوبات. فالعقوبات البديلة، بحكم طبيعتها، تتطلب انخراطا متعدد المستويات يشمل القضاء، والإدارة، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني، وهو ما يجعلها رهانًا معقدًا يختبر قدرات الدولة على التنسيق وعلى إعادة تعريف وظيفة العقوبة داخل النسق الاجتماعي ككل.
بهذا المعنى، فإن البيان التوضيحي ليس مجرد وثيقة إدارية عابرة، بل هو نص كاشف عن عمق التناقضات التي تحكم السياسات العقابية بالمغرب: بين الضغط التدبيري الذي تعانيه السجون، وبين الطموح الإصلاحي الذي يسعى إلى تقليص الاكتظاظ عبر إدماج العقوبات البديلة.
وهو ما يستدعي مقاربة سوسيولوجية تنصت لهذه التناقضات وتفككها في ضوء نظريات العقوبة والسلطة والانضباط الاجتماعي.
الخطاب الرسمي: أولوية التقنية على المجتمعي
يعكس البيان الصادر عن المندوبية نزعة تبريرية واضحة، إذ يسعى أساسا إلى نفي الأخبار “المغلوطة” وإبراز جاهزية المؤسسة من خلال عرض إجراءات تقنية ولوجستية، دون أن يتطرق إلى جوهر الإشكالات البنيوية التي يطرحها القانون الجديد. فالعقوبة البديلة لا تختزل في تجهيز منصات رقمية أو تكوين موظفين أو توفير أساور إلكترونية، بل تمثل قبل كل شيء تحولا في فلسفة العدالة ذاتها، من منطق الزجر والردع إلى منطق الإصلاح والإدماج.
هذا البعد الفلسفي يجعل من الصعب اختزال النقاش في الجانب الإداري وحده، إذ إن أي إصلاح جزئي يظل هشا ما لم يتكئ على تحولات أعمق في البنية الثقافية والاجتماعية للمؤسسات. وهنا نستحضر تصور إرفينغ غوفمان حول “المؤسسات الكلية”، حيث يرى أن مثل هذه المؤسسات، كالسجون والمصحات العسكرية والمصحات النفسية، لا يمكن أن تتغير جذريا عبر إجراءات تقنية فقط، لأن بنيتها تقوم على إعادة إنتاج أنماط من العزل والوصم والضبط الاجتماعي. ومن ثم فإن أي إصلاح جزئي يظل محدود الأثر، ما لم يصحب بعملية تحول شاملة في الثقافة المؤسسية وفي التصورات الاجتماعية للعقوبة والعدالة.
الثقافة العقابية والتضاد الاجتماعي
يظهر الواقع الاجتماعي المغربي أن التصور السائد للعقوبة ما يزال مرتبطا بشكل قوي بالسجن، باعتباره الجزاء “الشرعي” القادر على تحقيق الردع وحماية النظام الاجتماعي. وفي هذا السياق، يواجه إدماج بدائل عقابية مثل الخدمة المجتمعية أو المراقبة الإلكترونية تحديًا مزدوجا: فمن جهة، قد ينظر إليها اجتماعيا باعتبارها شكلًا من أشكال التساهل مع الجريمة؛ ومن جهة أخرى، قد تعجز عن أداء وظيفتها الرمزية في طمأنة المجتمع وإشباع حاجته إلى العدالة العقابية.
هذا التوتر يمكن مقاربته من خلال منظور بيير بورديو حول مفهوم الهابيتوس، أي تلك البنية العميقة من التصورات والممارسات الراسخة التي تحدد تمثلات الأفراد وسلوكياتهم. فالهابيتوس المغربي ما يزال يربط بين العقوبة وفقدان الحرية، ويجد صعوبة في استيعاب أن الخدمة المجتمعية أو المراقبة الإلكترونية يمكن أن تحمل القيمة الردعية نفسها.
وفي المقابل، يتيح منظور ميشيل فوكو فهم التحولات التاريخية التي عرفتها العقوبة، إذ لم تعد مجرد انتقام جسدي يمارس على الجسد، بل تحولت إلى تقنية للضبط والانضباط الاجتماعي. ومن هنا يطرح سؤال محوري: إلى أي حد يمكن للعقوبات البديلة أن تستبقي هذا الدور الضبطي في مجتمع لم يتصالح بعد مع فلسفة العدالة الإدماجية، ولا يزال مشدودا إلى منطق العقاب الزجري كوسيلة أساسية لتدبير الجريمة وضمان الأمن؟
التحديات المؤسساتية والتنسيقية
يشير البيان التوضيحي إلى أن أحد أسباب تعثر تنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة هو تزامن دخوله حيز التنفيذ مع موسم العطل الصيفية لمختلف القطاعات المعنية. غير أن هذا التفسير الظرفي يخفي في العمق إشكالية بنيوية مرتبطة بضعف التنسيق المؤسساتي بين الفاعلين المختلفين. فالعقوبات البديلة، بحكم طبيعتها، ليست شأنا إداريا محصورا في المندوبية العامة لإدارة السجون، بل هي مشروع مجتمعي يتطلب انخراط قطاعات متعددة: من التعليم الذي يمكن أن يحتضن أنشطة الخدمة المجتمعية، إلى الجماعات الترابية التي تتيح فضاءات للتنفيذ، مرورًا بالصحة التي قد تستوعب خدمات ذات بعد اجتماعي، وصولًا إلى المجتمع المدني الذي يفترض أن يشكل شريكا مركزيا في عملية الإدماج.
هذا التعثر يكشف عن هشاشة النسق المؤسساتي، ويعيد إلى الأذهان منظور تالكوت بارسونز الذي يرى أن المجتمع نظام متكامل تتوزع أدواره بين مؤسساته المختلفة. فإذا اختلّ أداء جزء من هذا النظام، تعطل أداء الكل، وظهرت التوترات البنيوية. وبالمثل، فإن أي محاولة لتنفيذ العقوبات البديلة بمعزل عن هذا التكامل بين القطاعات ستبقى محدودة الأثر، لأنها ستصطدم بإكراهات التنسيق والقدرة على توزيع المسؤوليات.
ومن هنا يتضح أن الرهان الحقيقي لا يكمن في توفير الوسائل التقنية فحسب، بل في بناء شبكة مؤسساتية متماسكة قادرة على تقاسم الأدوار بما يضمن فعالية هذا التحول في السياسة الجنائية.
السجن: بين ضغط الاكتظاظ واستراتيجية التخفيف
تعيش السجون المغربية منذ سنوات على وقع إشكاليات مزمنة، يأتي في مقدمتها الاكتظاظ الحاد وضعف الموارد البشرية واللوجستية، مما يجعلها في كثير من الأحيان عاجزة عن أداء أدوارها الإصلاحية. وفي هذا السياق، تطرح العقوبات البديلة كخيار يبدو للوهلة الأولى بمثابة حل إداري لتخفيف الضغط أكثر مما هو تحول جوهري في فلسفة السياسة الجنائية. وهنا يكمن الخطر: أن يتم اختزالها في مجرد آلية ظرفية لتدبير الأزمة السجنية، بدل أن تكون مدخلا لإعادة تعريف معنى العقوبة وإعادة النظر في علاقتها بالإدماج الاجتماعي.
من هذا المنظور، يصبح استحضار أطروحة إرفينغ غوفمان في كتابه الوصم أمرا ضروريا؛ إذ يوضح أن العقوبة التي لا تفضي إلى إدماج اجتماعي فعال تؤدي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى إعادة إنتاج التهميش والوصم. فحتى وإن لم تمارس العقوبة داخل أسوار السجن، فإن بدائلها قد تتحول إلى وسيلة لإدامة صور سلبية عن الجاني داخل محيطه الاجتماعي إذا لم تُصاحب ببرامج موازية للدعم والمواكبة. وبالتالي، فإن التحدي لا يكمن فقط في تخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية، بل في ضمان أن تشكل العقوبات البديلة فعلا فرصة لإعادة إدماج حقيقية، بدل أن تكون شكلا جديدا من “السجن الرمزي” أو من إعادة إنتاج الهامشية بوسائل أخرى.
نحو تحول سوسيولوجي في السياسة الجنائية
لكي تتحول العقوبات البديلة إلى بديل حقيقي وفعال داخل النظام الجنائي المغربي، لا يكفي الاكتفاء بالإجراءات التقنية والإدارية، بل يتطلب الأمر استراتيجية شاملة تتداخل فيها الأبعاد الثقافية والمؤسساتية والفلسفية للعدالة.
●أولا: الإصلاح الثقافي يعد شرطا أساسيا، ويقصد به نشر وعي قانوني واجتماعي جديد يعيد تشكيل التصورات الشعبية عن العقوبة، بحيث ينظر إليها ليس كوسيلة للعقاب الزجري فحسب، بل كأداة لإصلاح الفرد وإعادة إدماجه في المجتمع. هنا يمكن ربط هذا البعد بمفهوم الهابيتوس عند بيير بورديو، إذ أن تغيير التصورات والسلوكيات يتطلب إعادة بناء أنماط التفكير والسلوك الراسخة في الثقافة المجتمعية.
● ثانيا: التنسيق المؤسسي الواسع يمثل شرطا لا غنى عنه لضمان التنفيذ الفعلي للعقوبات البديلة. فهذه العقوبات ليست مسؤولية المندوبية وحدها، بل تتطلب انخراطا متضافرا للقطاعات القضائية، والتعليمية، والصحية، والجماعات الترابية، فضلا عن المجتمع المدني. وفقًا لنظرية تالكوت بارسونز، لا يمكن لأي جزء من النظام الاجتماعي أن يؤدي وظيفته بفعالية إلا إذا تحقق التكامل مع بقية أجزائه، وإلا ظهرت اختلالات تحد من أثر أي إصلاح.
●ثالثا: لا بد من رؤية شمولية للعدالة الجنائية، تجعل من العقوبة أداة للإصلاح والإدماج بدل أن تبقى مجرد وسيلة للردع أو التدبير الأمني. وهنا يتقاطع هذا الطرح مع تحليل ميشيل فوكو لطبيعة السلطة والانضباط، حيث يشير إلى أن العقوبة الفعّالة هي التي توازن بين ضبط السلوك وإعادة الإدماج الاجتماعي، وليس مجرد ممارسة للسيطرة أو الحرمان من الحرية.
باختصار، يشكل هذا المزيج بين الإصلاح الثقافي، والتنسيق المؤسساتي، والرؤية الشمولية للعدالة شرطا أساسيا لتحويل العقوبات البديلة من مجرد حل إداري ظرفي إلى استراتيجية إصلاحية حقيقية قادرة على إحداث أثر ملموس في المجتمع والنظام القضائي المغربي.
يبين البيان الرسمي للمندوبية أن هناك إرادة سياسية واضحة لتفعيل مقتضيات القانون 43.22، غير أن القراءة السوسيولوجية تكشف عن توتر جوهري بين الطموح القانوني والواقع الثقافي والمؤسساتي. فالعقوبات البديلة، إذا اقتصرت على كونها أداة لتخفيف الضغط عن السجون أو حل إداري ظرفي، فإن أثرها سيظل محدودا، ولن تسهم بشكل فعلي في إعادة صياغة العلاقة بين المجتمع والجريمة.
على العكس، فإن ربط هذه العقوبات بـتحول ثقافي ومؤسساتي عميق، يشمل إعادة بناء التصورات الشعبية حول العدالة، وتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات، وإرساء رؤية شمولية للعدالة الجنائية، من شأنه أن يحقق إدماجا حقيقيا للمجرمين في المجتمع ويعيد تعريف وظيفة العقوبة نفسها.