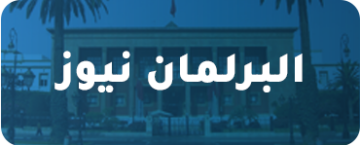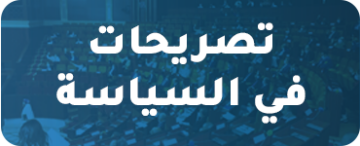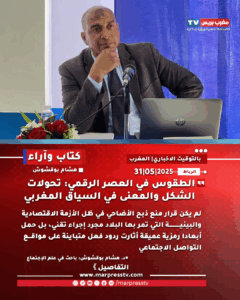الطقوس في العصر الرقمي: تحولات الشكل والمعنى في السياق المغربي
هشام بوقشوش*|أدى التحول الرقمي إلى إعادة صياغة العديد من الأنساق الرمزية والاجتماعية، وعلى رأسها الطقوس باعتبارها أنماطا جماعية من التعبير الرمزي. ففي المغرب، حيث ما تزال الطقوس الدينية والاجتماعية تحظى بثقل ثقافي وتاريخي كبير، برزت تحولات نوعية في طريقة ممارستها وتلقيها، بفعل انتشار الوسائط الرقمية وتطور استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.
تقوم الطقوس التقليدية في المغرب – كرمضان، عيد الأضحى، حفلات الزواج، أو الجنائز – على الاجتماع المادي والحضور الجسدي الجماعي. لكن في العصر الرقمي، لم يعد هذا الحضور شرطا للانخراط الطقسي. فمثلا، أصبحت المعايدات تتم عبر الرسائل الفورية، وطقوس العزاء تختصر في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما توثق الأسر لحظات الذبح أو الإفطار وتنشرها على إنستغرام وتيك توك.هذا الانتقال من الفعل الطقسي الواقعي إلى الفضاء الافتراضي، يكشف عن تحول الطقس إلى تجربة فردية مرئية، يظهر فيها الجانب الرمزي موجها للعرض والاستهلاك، أكثر من كونه وسيلة للتماسك الجماعي.
لم يكن قرار منع ذبح الأضاحي في ظل الأزمة الاقتصادية والبيئية التي تمر بها البلاد مجرد إجراء تقني، بل حمل أبعادا رمزية عميقة أثارت ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.تفاعل المغاربة عبر هذه المنصات الرقمية يعكس صراعا رمزيا بين رؤيتين: الأولى مؤيدة للقرار، ترتكز على منطق الحفاظ على الثروة الحيوانية والاقتصاد الوطني، وتبرز أهمية الاستدامة في مواجهة الجفاف وارتفاع الأسعار، والثانية معارضة، ترى في منع الذبح انتهاكا لتقاليد عريقة تشكل جزءًا من الهوية الدينية والثقافية للمجتمع. من منظور بيير بورديو، هذا الصراع هو صراع رأس المال الرمزي بين من يمتلك الشرعية القائمة على العقلانية العلمية والتنموية، ومن يدافع عن الشرعية المستمدة من التراث والهوية الدينية.
كما أن بعض المعارضين قد شعروا بأن القرار يحمل وصمة اجتماعية، حيث ينظر إلى من يلتزم بالمنع كمن يتخلى عن جزء من هويته الدينية، وهو ما يمكن تفسيره عبر نظرية إرفينغ غوفمان حول الوصمة الاجتماعية وإدارة الهوية في المجتمع. أما المؤيدون، فعملوا على إعادة بناء تلك الهوية بما يتوافق مع القيم الجديدة التي تركز على المسؤولية الجماعية والاعتبارات البيئية.على الصعيد الاقتصادي، يظهر القرار كاستجابة للضغوط المعيشية على الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، في ظل تراجع الثروة الحيوانية وارتفاع أسعار اللحوم، ما يعكس أبعادا طبقية في هذا الصراع، حيث يستفيد الفلاحون والمربون من موسم الأضاحي كمصدر دخل هام، ما يفاقم التوتر بين الفئات الاجتماعية.
ولا يمكن إغفال دور مواقع التواصل الاجتماعي في هذا السياق كمساحة لنقل وتشكيل المواقف، لكنها أيضًا بيئة خصبة لانتشار الإشاعات، مثل الأخبار عن فرض غرامات مالية على ذبح الأضاحي، ما أضعف الثقة بين المواطنين والسلطات، وأدى إلى أزمة تواصل وتضليل.يعكس هذا التفاعل مدى تعقيد التوازن بين التقاليد والحداثة في المجتمع المغربي، ويطرح تساؤلات جوهرية حول كيفية إدارة الهوية الثقافية والدينية في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية، ويتطلب تواصلًا مجتمعيًا واضحًا وحوارًا شاملاً للحفاظ على التماسك الاجتماعي.
يؤدي الرقمي دورا في إعادة تشكيل المعاني المرتبطة بالطقوس. فإذا كانت هذه الأخيرة تمثل في السابق لحظة لإعادة إنتاج القيم الجماعية، والروابط الأسرية، والانتماء الديني، فإن الطقوس الرقمية تعيد إنتاج هذه الرموز داخل منطق التفاعل حال المنع ، تتحول عبره المشاهدة، والمشاركة.فالطقس – كمشهد مُصور – يتحول إلى محتوى يشيد بضرورة الامتثال لقرارات الدولة ، أو النكاية والتشفي في أصحاب ضيعات المواشي، كأحد الأشكال الممعنة في البعد الرمزي العميق للعيد بعدم الممارسة، ويجعل من معارضة قرارات الدولة مروقا من الدين وعدم الطاعة لولي الأمر.لم يعد مناهضة الطقس استثناء في العصر الرقمي مجرد ممارسة ثقافية عفوية، بل أصبح موضوعًا للتنظيم والتحكم من قبل الفاعلين الرسميين. ففي المغرب، تستثمر الدولة الرقمنة في ضبط المجال الديني.
إجراءات منع إقامة شعيرة الذبح فرضت من خلال الرقمنة فاعلين جددًا في مجال الطقوس، أبرزهم “المؤثرون” و”اليوتيوبرز الدينيون واللادينيون”، الذين يعيدون إنتاج محتوى طقسي موجه للجمهور الرقمي، مما يعزز الشخصنة في تمثيل الدين والاحتفال. فبدل أن تكون الطقوس لحظة جماعية للتقديس وعد التقديس، أصبحت سرديات ذاتية و”قصص ستوري” توثق الإيمان ضمن منطق الاستهلاك أو الوصم بالجهل المقس.إن الطقوس في العصر الرقمي لا تموت، بل تتحول. فهي تفرغ من بعض وظائفها الجماعية التقليدية، لكنها تكتسب في المقابل طاقات جديدة للتعبير عن الذات والهوية، وإن كان ذلك ضمن شروط السوق الرقمية وثقافة التفاعل السطحي. وفي السياق المغربي، تبدو هذه التحولات جلية في كل من عيد الأضحى، رمضان، والمناسبات الاجتماعية، حيث تتجاور الممارسات التقليدية مع تجلياتها المرقمنة، في مشهد هجين ومعقد.
د. هشام بوقشوش: باحث في علم الاجتماع