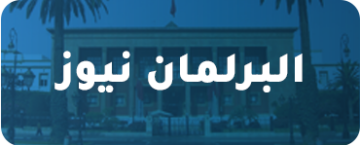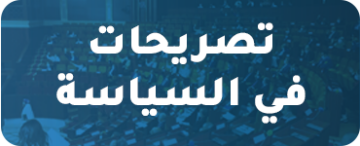سوسيولوجيا الاغتصاب الجماعي للأطفال: قراءة تكاملية في الفضاءات المناسباتية المغربية
من المنظور النفسي–المرضي، يفسر الاغتصاب الجماعي للأطفال بوجود اضطرابات سلوكية وانحرافات جنسية مرضية (paraphilias)، أو بسمات سيكوباتية ونرجسية تجعل الفرد عاجزا عن ضبط غرائزه الجنسية وتعامله مع الآخر كموضوع للسيطرة لا كذات مستقلة.
■ د. هشام بوقشوش |باحث في علم الاجتماع
الرباط|يعد الاغتصاب الجماعي للأطفال من أخطر الجرائم التي تهزّ المجتمعات ليس فقط لكونها تمس الفئات الأكثر هشاشة، بل لأنها تكشف التناقضات البنيوية التي ينطوي عليها النظام الاجتماعي والثقافي. فالطفل في المخيال الجماعي يمثل البراءة والضعف، وبالتالي فإن انتهاكه جنسيا – وبشكل جماعي – يشكل خرقا فاضحا للحدود الأخلاقية والرمزية التي يستند إليها المجتمع في إعادة إنتاج ذاته. من هنا، تتحول هذه الجريمة إلى صدمة اجتماعية مزدوجة: صدمة أخلاقية تمس الضمير الجمعي، وصدمة سوسيولوجية تكشف هشاشة آليات الحماية والرعاية الاجتماعية، وتعري في الآن ذاته العلاقة المتوترة بين المقدس والمدنس داخل الفضاءات العمومية.
تختلف المقاربات في تفسير الظاهرة؛ إذ تميل القراءات السيكولوجية إلى ربطها بانحرافات مرضية فردية، كاضطرابات السيطرة على الغرائز أو الميول الجنسية الشاذة، بينما تؤكد السوسيولوجيا أن هذه الأفعال لا تنفصل عن البنية الاجتماعية والثقافية، بل تنغرس في شبكة من العلاقات الرمزية والقيمية التي تمنحها، ولو ضمنيا، إمكان التحقق. فالمجتمع، من خلال الهيكل السلوكي المكتسب وآليات تنشئته الاجتماعية، ينتج أنماطا من السلوك والعلاقات تجعل العنف الجنسي ممارسة ممكنة في ظروف معينة، بل أحيانا وسيلة لإثبات الرجولة والهيمنة.
في السياق المغربي، يبرز الموسم الديني باعتباره نموذجا دالا لتحليل الظاهرة في فضاء مناسبتي ذي كثافة بشرية هائلة. فهذا الموسم الذي يجمع بين البعد الديني–الروحي (زيارة الزاوية وتقديس الولي) والبعد الاحتفالي–الفرجوي (التبوريدة، الأسواق، الحفلات) يخلق وضعية انتقالية تعلق فيها القواعد الاجتماعية الصارمة وتضعف فيها آليات الضبط الاجتماعي. وبفعل هذا التوتر بين المقدس والمدنس، تتسع الهوامش التي تسمح بظهور ممارسات عنيفة، بما فيها العنف الجنسي الموجّه ضد الأطفال.
إن توافد آلاف الأسر، انتشار الخيام كفضاءات مفتوحة غير مضبوطة، ضعف الحماية المؤسسية، والهشاشة الاجتماعية التي تدفع أطفالًا إلى التجوال في الموسم دون رعاية، كلها عوامل تجعل من الموسم بيئة مثالية لظهور سلوكيات خطرة. فالفضاء المناسباتي هنا لا يشكل مجرد خلفية محايدة، بل هو عامل منتج للعنف، لأنه يوفر ظروفا اجتماعية استثنائية تعيد إنتاج ديناميات السلطة الذكورية بشكل مكثف، حيث يصبح الجسد الطفولي الحلقة الأضعف في سلسلة الهيمنة.
من هذا المنطلق، يمكن القول إن الاغتصاب الجماعي للأطفال ليس مجرد فعل شاذ أو انحراف نفسي، بل هو مرآة تعكس بنية اجتماعية تشرعن العنف بطرق صريحة أو ضمنية. إنه يكشف عن حدود النظام التربوي، هشاشة منظومة الحماية، واستمرار ثقافة ذكورية ترى في السيطرة على الآخر وسيلة لتثبيت موقعها داخل الهرم الاجتماعي. وهنا، تتجلى أهمية المقاربة السوسيولوجية النقدية، لأنها تخرج الظاهرة من نطاق “المرض الفردي” إلى مجال العنف البنيوي الذي يعاد إنتاجه عبر الثقافة، التربية، والمؤسسات.
البعد النفسي والمرضي
من المنظور النفسي–المرضي، يفسر الاغتصاب الجماعي للأطفال بوجود اضطرابات سلوكية وانحرافات جنسية مرضية (paraphilias)، أو بسمات سيكوباتية ونرجسية تجعل الفرد عاجزا عن ضبط غرائزه الجنسية وتعامله مع الآخر كموضوع للسيطرة لا كذات مستقلة. هذه المقاربة، رغم أهميتها في إبراز البعد المرضي لدى بعض الجناة، تحوّل الجريمة إلى فعل فردي معزول عن السياق الاجتماعي، وتغفل أن الفعل الجنسي الإجرامي غالبا ما يتم داخل منطق جماعي يتجاوز مسؤولية الفرد.
فالاغتصاب الجماعي لا يقتصر على إشباع رغبة جنسية منحرفة، بل يتحول في كثير من الحالات إلى طقس اجتماعي يعاد من خلاله إنتاج السلطة الذكورية وإثبات “الرجولة” أمام الجماعة. وهنا يظهر البعد السوسيولوجي: فالفعل يصبح وسيلة لإعادة توزيع القوة داخل المجموعة، حيث يكتسب الفرد مكانته من خلال مشاركته في السيطرة على الجسد الأضعف، أي جسد الطفل. وبذلك، يتحول الاعتداء من فعل شاذ فردي إلى أداء جماعي للهيمنة، تتداخل فيه الرغبة المرضية مع الهابيتوس الذكوري المتجذر في الثقافة.
إن الاقتصار على التفسير النفسي المرضي يُبقي الظاهرة في حدود “العلة الفردية”، بينما القراءة السوسيولوجية تكشف أن ما يبدو مرضًا فرديًا يجد شرعيته في البنية الثقافية–الاجتماعية. فالمجتمع الذي يطبع العنف الرمزي ضد الأطفال، ويتسامح مع الخطاب الذكوري المشرعن للهيمنة، يوفر بيئة تسمح بتحول الانحراف الفردي إلى ممارسة جماعية مُنظمة.
البعد الاجتماعي–الثقافي
ترى السوسيولوجيا أن الاغتصاب الجماعي للأطفال لا يمكن النظر إليه كـ”صدفة نفسية” أو مجرد انحراف فردي، بل هو نتاج بنية اجتماعية حاضنة، تتقاطع فيها مجموعة من العوامل الرمزية والمادية التي تمنح هذا الفعل إمكان التحقق. فمن منظور بورديو، يتجذر الهابيتوس الذكوري داخل الثقافة المغربية، بحيث يرسخ فكرة السيطرة على الجسد، وخاصة الجسد الطفولي والأنثوي، كآلية لإثبات الهوية الرجولية داخل المجموعة. هذه السيطرة ليست مجرد فعل فردي معزول، بل أداء اجتماعي يكسب الفاعل مكانة ضمن منطق الهيمنة الذكورية.
في السياق ذاته، يظل التابو الجنسي أحد المرتكزات الأساسية التي تهيكل العلاقة بالمحظورات. فالجنسانية تقدّم في التربية الأسرية والمؤسساتية كموضوع مسكوت عنه، لكنّها في الواقع تتحول إلى ممارسة سرية مشبعة بالعنف، حيث يغيب البعد الحقوقي والتربوي، ويستعاض عنه بأشكال من التجريب القهري والعنيف. وهذا الصمت حول الجنسانية يضاعف هشاشة الأطفال، الذين يصبحون موضوعا سهلا للانتهاك بسبب غياب التربية الوقائية والوعي بحقوق الجسد.
إلى جانب ذلك، تفاقم الهشاشة الاجتماعية الوضعية؛ فالأطفال الذين يجدون أنفسهم في فضاءات عمومية أو مناسباتية ضخمة (مثل المواسم) دون رعاية أسرية أو حماية مؤسساتية يصبحون عرضةً للاستغلال، خصوصا وسط حشود يغيب فيها الضبط الأمني وتضعف فيها المراقبة. وهنا يتحول الفضاء المناسباتي إلى بيئة خطرة تكشف حدود الدولة والمجتمع في ضمان أمن الطفولة.
يشرعن تطبيع العنف الرمزي ضد الفئات الهشة مثل الأطفال استمرارَ هذه الظاهرة. إذ يُنظر إليهم أحيانا كـ”أجساد قابلة للاستعمال” بدل اعتبارهم ذواتا محمية بالحقوق. هذا المنطق يكرس لا مساواة عميقة في القيمة الإنسانية، ويفتح المجال أمام العنف الجنسي باعتباره ممارسة ممكنة، بل أحيانا غير مرئية، داخل النسيج الاجتماعي.
إن تداخل هذه العوامل يوضح أن الاغتصاب الجماعي للأطفال ليس مجرد انحراف، بل هو انعكاس مباشر لبنية ثقافية–اجتماعية تعيد إنتاج العنف والهيمنة بأشكال مختلفة، وتكشف عن التناقض بين الخطاب القيمي الذي يمجد حماية الطفولة، والممارسة الاجتماعية التي تفرغ هذه الحماية من مضمونها.
خصوصية الفضاء المناسباتي
يمثل الموسم الديني حالة نموذجية لفهم ديناميات العنف الجنسي ضد الأطفال، لأنه فضاء يتقاطع فيه المقدس والمدنس بشكل حاد. فمن جهة، يقوم الموسم على طقوس دينية وروحية مرتبطة بالزاوية وبقدسية الولي، وهو ما يمنحه هالة رمزية من الشرعية والتطهير. ومن جهة أخرى، تنبثق داخله ممارسات مدنسة: استهلاك الخمور والمخدرات، العلاقات العابرة، والانفلات السلوكي. هذا التناقض البنيوي لا ينتج فقط ازدواجية في المعنى، بل يفتح المجال أمام مساحات من اللامراقبة حيث تختفي الحدود بين المشروع والممنوع، وتتعطل مؤقتا قواعد الضبط الاجتماعي.
إن الفضاء المناسباتي بهذا الشكل يتحول إلى فضاء انتقالي بالمعنى الذي قصده فيكتور تيرنر ، أي فضاء يعلق البنيات الاجتماعية الصارمة ويخلق حالة من السيولة الرمزية والاجتماعية. في هذه اللحظة الانتقالية، يتراجع حضور الدولة ومؤسساتها الرقابية، وتستبدل بآليات عرفية أو فوضوية لا تملك القدرة على حماية الفئات الهشة، وعلى رأسها الأطفال.
تظهر هذه الوضعية كيف يمكن للمجتمع أن يسقط أقنعته مؤقتا، فينكشف عمق البنية الثقافية المرتبطة بالجسد والجنسانية والسلطة الذكورية. فالموسم لا يصبح فقط مجالا للفرجة أو الترفيه، بل أيضا مختبرا سوسيولوجيا يجسد علاقة المجتمع المغربي بجسده وجنسانية أفراده. الأطفال في هذا السياق يتحولون إلى الحلقة الأضعف داخل لعبة التوتر بين المقدس والمدنس: فهم يفتقدون آليات الحماية الأسرية والمؤسساتية، وفي الوقت ذاته يصبحون عرضة لتمثلات جسدية تعتبرهم موضوعًا للمتعة القسرية أو للتجريب الجنسي العنيف.
بذلك، فإن الموسم الديني لا يختزل في كونه مناسبة ثقافية–دينية، بل هو فضاء فوضوي منتج للعنف، يكشف كيف تتجسد الهيمنة الذكورية في أكثر صورها قسوة حين تختفي الضوابط الاجتماعية، ويختبر فيها الحدّ الفاصل بين الثقافة والوحشية، وبين الشرعية الدينية والانفلات الجنسي.
قراءة نقدية
إن أي مقاربة نقدية لظاهرة الاغتصاب الجماعي للأطفال تفرض تجاوز ثنائية التفسير التقليدية التي تحيل إما إلى “المرض النفسي” أو إلى “الخلل الاجتماعي”. فالظاهرة لا يمكن اختزالها في اختلال فردي معزول، ولا في بنية اجتماعية كلية تحجب مسؤولية الفاعل. لذلك يصبح المدخل الأكثر وجاهة هو المنظور التكاملي الذي يجمع بين البعدين: الفردي والنسقي.
فمن جهة، لا يمكن إنكار أن بعض الجناة يعانون من انحرافات مرضية فردية أو اضطرابات في ضبط الغرائز والسلوكيات، وهو ما يستوجب تشخيصا دقيقا وتدخلا علاجيا–نفسيا يندرج ضمن مسؤولية الطب الشرعي وعلم النفس العيادي. هذا البعد يعيد الاعتبار للفرد كفاعل مسؤول، لكنه أيضا كذات مريضة تحتاج إلى علاج لا إلى العقاب فقط.
ومن جهة أخرى، فإن الاقتصار على البعد المرضي يغفل حقيقة أن هذه الانحرافات لا تظل حبيسة الفرد، بل تجد في البنية السوسيولوجية ما يسمح بتمددها وانتشارها. فالثقافة الذكورية، التابوهات الجنسية، الهشاشة الاجتماعية، وضعف آليات الحماية، كلها عوامل تجعل من الانحراف الفردي ممارسة جماعية قابلة للشرعنة الضمنية.
يتضح من خلال هذه القراءة النقدية أن الاغتصاب الجماعي للأطفال لا يمكن فهمه في عزلة عن جدلية الفرد–المجتمع، ولا عن السياق الثقافي–الاجتماعي الذي يشرعن ضمنيا بعض أشكال العنف ويطبع معها. فالتفسير النفسي المرضي وحده قاصر لأنه يحصر الجريمة في اختلالات فردية، كما أن التفسير السوسيولوجي المحض يظل ناقصًا لأنه يُغفل الفاعل الفردي. وبين هذين القصورين، تظهر الحاجة إلى منظور تكاملي يرى في الجريمة فعلًا ينتج عند تقاطع: اضطرابات نفسية مرضية، هشاشة اجتماعية، ثقافة ذكورية، وتابوهات جنسية متجذرة.
يمثل الموسم الديني نموذجا كاشفا لهذه الدينامية، إذ يضعنا أمام فضاء انتقالـي يسقط مؤقتا آليات الضبط الاجتماعي، فيظهر التناقض بين المقدس والمدنس، وبين الخطاب الذي يمجد حماية الطفولة والممارسة التي تُعرّي هشاشتها.
إن مواجهة الظاهرة لا تتطلب فقط أدوات الردع والعقاب، بل أيضا بناء سياسات وقائية–علاجية متكاملة، تعالج الفرد في بعده المرضي والنفسي، وتفكك البنية الثقافية والاجتماعية التي تجعل من جسد الطفل مجالا مشروعا للعنف الرمزي والمادي. هكذا فقط يمكن الانتقال من مقاربة جزئية إلى رؤية شمولية تعيد الاعتبار للطفولة كقيمة إنسانية عليا، وتحمي المجتمع من إعادة إنتاج آليات العنف والهيمنة في صور أكثر قسوة.
إن الاغتصاب الجماعي للأطفال، كما يتجلى في الفضاءات المناسباتية مثل المواسم الدينية، لا يختزل في كونه انحرافا فرديا أو شذوذا نفسيا، بل يمثل مرآة عاكسة لخلل اجتماعي–ثقافي عميق. فهو جريمة تفضح هشاشة آليات الضبط الاجتماعي، وضعف سياسات حماية الطفولة، واستمرار ثقافة ذكورية تجعل من الجسد مجالًا لإعادة إنتاج السلطة والهيمنة.
إن مقاربته سوسيولوجيا تكشف عن كونه ظاهرة اجتماعية مركبة تتقاطع فيها البنى النفسية والنسقية: من اضطرابات فردية مرضية إلى ثقافة جماعية مطبّعة مع العنف. هذا ما يفرض مساءلة جذرية للبنيات الثقافية والتربوية والدينية التي تشرعن ضمنيا العنف الجنسي، ويستدعي في الآن ذاته بلورة سياسات عمومية وقائية وعلاجية تعيد الاعتبار للطفولة كقيمة إنسانية، وتعيد ضبط العلاقة بين الفرد والمجتمع في أفق الحدّ من إعادة إنتاج العنف.