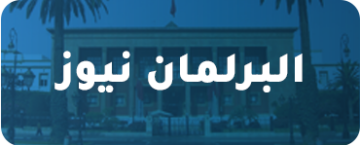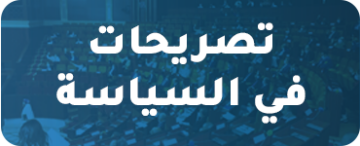السلوك المدني في المغرب: أفق نقدي بين الهوية الدينية.. التنشئة الاجتماعية والتحولات المجتمعية
يأتي تقرير “السلوك المدني لدى المغاربة”، الصادر عن المركز المغربي للمواطنة في ماي 2025، في سياق مجتمعي متحول يتسم بتغيرات بنيوية عميقة على المستويين العمراني والاجتماعي، حيث تشهد القيم الجماعية التقليدية حالة من التآكل أمام تصاعد الفردانية وتراجع آليات الضبط الاجتماعي داخل الفضاء العام.

وقد انطلقت هذه الدراسة من هدف مركزي يتمثل في رصد تمثلات وممارسات المواطنين المغاربة في الفضاء العام، والكشف عن مدى التزامهم بقيم السلوك المدني في ظل هذه التحولات.من الناحية المنهجية، اعتمد التقرير على استطلاع إلكتروني أجري خلال الفترة الممتدة بين فبراير ومارس 2025، وشارك فيه 1173 مواطنًا ومواطنة، بلغت نسبة الذكور بينهم 76%، بينما صرّح 44% بأنهم من حاملي الشهادات الجامعية العليا. وقد تميزت العينة بتمثيل مجالي متركز في المدن الكبرى، وعلى رأسها الرباط، الدار البيضاء، وفاس، ما يوفر قاعدة معطيات غنية تسمح بفهم تمثلات الفئات الحضرية المتعلمة تجاه قضايا المواطنة والسلوك العام.
وفي هذا السياق، نسعى من خلال هذه الورقة إلى إجراء قراءة سوسيولوجية نقدية لمخرجات هذا التقرير، لا بهدف إعادة إنتاج خلاصاته الوصفية، بل بغرض تفكيك البنيات الرمزية والاجتماعية التي تحكم السلوك المدني في المغرب، واستجلاء التوترات البنيوية بين القيم المعلنة والممارسات الفعلية، وبين الهوية الدينية التي تؤطر الخطاب الاجتماعي، والواقع العملي داخل الفضاء العام.
يمثل السلوك المدني في الفضاء العام مرآة دقيقة لمعنى المواطنة ودرجة تطور المجتمع. وفي المغرب، تبرز أزمة عميقة تكمن في التباين بين الخطاب الديني والثقافي الذي يؤكد على قيم الاحترام، الانضباط، والكرامة، وبين الممارسات اليومية التي تكشف عن تراجع في هذه القيم. هذا التباين لا يعكس فقط قصورا في التزام الأفراد، بل يشير إلى أزمة أوسع في المؤسسات والأنظمة التي تحكم الفضاء الاجتماعي.
يمكننا فهم هذه الأزمة عبر مفهوم العنف الرمزي كشكل غير مباشر من الهيمنة يمارس عبر المؤسسات والقيم التي يفرضها الحقل الاجتماعي على الأفراد، دون اللجوء إلى القوة المادية المباشرة. في المغرب، كانت المؤسسات الدينية والتربوية والعائلية تملك سلطة رمزية لضبط السلوك وضمان انسجامه مع المعايير القيمية. لكن مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، بدأت هذه الهيمنة الرمزية تفقد فعاليتها، مما أدى إلى ظهور سلوكيات تفسر كإفلات من الالتزام بالقواعد العامة (كالتعدي على الملك العام، رمي النفايات، الغش التجاري).
يمثل هذا التراجع في ضبط السلوك مؤشرا على أزمة في توزيع وإعادة إنتاج رأس المال الرمزي بين فئات المجتمع، حيث ينتشر الإهمال للفضاء العام في أوساط واسعة، خاصة مع غياب منظومة عقابية فعالة. بالتالي، لا ينظر إلى القواعد الاجتماعية باعتبارها قواعد ملزمة بل كخيارات متغيرة، ما يؤدي إلى ضعف السلوك المدني.
يرتبط هذا التباين أيضا بمفهوم الهوية كما صاغه إرفينغ غوفمان، الذي يرى أن الهوية تتشكل في حقل التفاعل الاجتماعي من خلال التوافق أو الصراع بين الهوية المتصورة (ما يعتقد الفرد أنه عليه) والهوية المعروضة (كيف يراه الآخرون). في المغرب، تمثل الهوية الدينية والثقافية جزءا هاما من الهوية المتصورة، لكنها لا تجد تجسيدا كافيا في الهوية المعروضة بالسلوك العملي في الفضاء العام.ينتج عن هذا فجوة بين الصورة الذاتية للمواطن وفعالية التمثيل الاجتماعي، تنتج شعورا بالوصم والإحباط، وأحيانا تفككا في الروابط الاجتماعية، إذ يتراجع الالتزام المشترك بالقوانين والأنظمة. وبذلك، تتعزز ظاهرة التديّن الشكلي الذي يرتبط بالممارسات الطقسية دون ترجمتها إلى سلوك مدني يومي.
يلعب مفهوم الهابيتوس لبورديو دورا مركزيا في تفسير هذه الظاهرة، كمنظومة المواقف، التصرفات، والأنماط السلوكية المكتسبة عبر التنشئة الاجتماعية، والتي تحدد سلوك الأفراد داخل المجتمع. الأسرة والمدرسة هما المؤسستان الرئيسيتان اللتان تنقلان هذه القيم وتكونان الهابيتوس المدني.يظهر التقرير ضعفا في فاعلية هاتين المؤسستين في غرس السلوك المدني، على الرغم من اعتراف المشاركين بدورهما. هذا يشير إلى أن التنشئة الاجتماعية لم تواكب التحولات التي طرأت على المجتمع، مثل التحولات العمرانية، والتوسع الحضري، وانتشار الفردانية، التي أثرت على شبكة العلاقات الاجتماعية.
يضاف إلى ذلك غياب برامج تعليمية واضحة ومتخصصة في التربية المدنية، وكذلك غياب القدوة الفاعلة التي تمثل نموذجا للسلوك المدني. هنا تتدخل نظريات التنشئة الاجتماعية التي تؤكد على أهمية التفاعل المستمر بين الفرد ومحيطه في تكوين الأنماط السلوكية، وهو ما يتعذر تحقيقه في ظل الفوضى وعدم احترام القوانين.
يبرز التقرير أن التحولات العمرانية والاجتماعية التي شهدها المغرب أسهمت في تغيير أنماط التفاعل الاجتماعي، حيث تفكك التضامن التقليدي وانتشر نمط الفردانية. هذا التغير له أثر مباشر على السلوك المدني، لأن الفردانية تعني ضعف الالتزام تجاه الجماعة، وتراجع الشعور بالمسؤولية المشتركة تجاه الملك العام والفضاء العام.ينعكس هذا في سلوكيات مثل رمي النفايات، احتلال الملك العام، وعدم احترام قواعد السير واللباس. كما تتفاقم هذه الظاهرة بفعل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، حيث يشعر بعض الأفراد أو الفئات بتهميش رمزي أو اقتصادي، مما قد يدفعهم إلى التعبير عن هذا التهميش عبر تجاهل القواعد العامة.
يلاحظ من التقرير أن ضعف الالتزام بالقوانين يرتبط ارتباطا وثيقا بعدم كفاية تطبيق العقوبات، ما يشجع على الإفلات من العقاب ويؤدي إلى انتشار السلوكيات غير المدنية. القانون وحده، بدون دعم مجتمعي وثقافي، لا يمكنه فرض السلوك، خصوصًا إذا كان غير مستند إلى إحساس بالمسؤولية والمواطنة.كما أن غياب شرطة القرب ومحدودية آليات الرقابة الاجتماعية تجعل من الصعب ضبط السلوك في الفضاءات العامة، مما يعزز الفوضى ويضعف الانضباط.
يشير التقرير إلى أن استضافة المغرب لكأس العالم 2030 تمثل فرصة استراتيجية لإطلاق حملات وطنية لتعزيز السلوك المدني، وتحسين صورة البلد في الداخل والخارج. هذه الفرصة تفرض على الدولة والمجتمع مد جسور التعاون لإعادة بناء ثقافة المواطنة، عبر برامج توعوية، تعزيز دور المؤسسات التعليمية، وتفعيل القوانين بصرامة وعدالة.
إن أزمة السلوك المدني في المغرب ليست أزمة قيم جوهرية، بل أزمة في كيفية نقل هذه القيم وترجمتها إلى سلوك. الهوية الدينية التي تمثل جزءا هاما من الثقافة المغربية، تحتاج إلى ربط أوثق بالمسؤولية المدنية والممارسة اليومية، حتى لا تبقى مجرد طقوس شكلية.
تقتضي معالجة أزمة السلوك المدني في المغرب تبني مقاربة سوسيولوجية شمولية تتجاوز الحلول التقنية الظرفية، نحو بناء بنية تحتية رمزية وقيمية تنطلق من فهم عميق لتحولات المجتمع المغربي. في هذا السياق، تعد التربية المدنية نقطة ارتكاز أساسية لإعادة إنتاج الهابيتوس المدني، أي ذلك النظام الباطني من الاستعدادات الذهنية والسلوكية الذي يتشكل من خلال التنشئة الاجتماعية في الأسرة والمدرسة. غير أن بناءه يظل هشا في ظل غياب عقاب مؤسساتي واضح، ما يستدعي تفعيل أدوات الدولة الضبطية، ليس فقط من خلال الردع، بل عبر خلق شعور عام بالعدالة يحفّز الالتزام الطوعي بالقوانين.
في المقابل، لا يمكن إغفال التحولات الاجتماعية التي رسخت أنماطا من الفردانية الدفاعية، نتيجة تفكك شبكات التضامن التقليدية وغياب البدائل المؤسساتية، مما يجعل من الضروري تفعيل برامج تشجع على المشاركة المجتمعية وتعيد نسج روابط الانتماء. كما يفرض الواقع إعادة النظر في دور المؤسسة الدينية التي فقدت في الكثير من السياقات قدرتها على التأطير العملي، لصالح خطاب شكلي لا يمس السلوك اليومي. لذا، فربط الدين بالسلوك المدني اليومي—لا عبر الوعظ فقط، بل عبر القدوة الفعلية—يمثل مسارا ضروريا لاستعادة المعنى الاجتماعي للقيم الدينية.
إن استحقاقات كبرى مثل كأس العالم 2030 تشكل لحظة رمزية يمكن استثمارها لإطلاق مبادرات توعوية تحفيزية، تحول فيها الوطنية من شعار إلى ممارسة مدنية مسؤولة. هكذا فقط يمكن تحويل الخطاب الديني والوطني من مجرد هوية رمزية إلى قوة اجتماعية ضابطة، تعيد ترسيخ ثقافة الاحترام، الانضباط، والتكافل كأعمدة للمواطنة الفاعلة.
د. هشام بوقشوش / باحث في علم الاجتماع